
«الاستعمار لا يصنع الشرائح، بل يستغلها حين يجدها نائمة في جسد المجتمع»- مالك بن نبي
في خضم التحديات التي تواجهها الدولة الوطنية الحديثة، تبرز ظاهرتا الشرائحية والطائفية كأخطر التهديدات التي تنخر جسد المجتمعات وتُضعف تماسكها الداخلي، وتُعرّف الشرائحية في علم الاجتماع بأنها الانقسام العمودي للمجتمع إلى طبقات مغلقة، يُحدَّد فيها موقع الفرد الاجتماعي مسبقًا على أساس النسب أو اللون أو الوظيفة الوراثية، مما يُنتج تراتبية جامدة كثيرًا ما تكون عائقًا أمام العدالة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
أما الطائفية، فهي انغلاق الجماعة على مرجعية دينية أو مذهبية تجعل ولاء الأفراد موجّهًا للطائفة وليس للوطن.
وعلى الرغم من الفروق المفاهيمية بين المصطلحين (الشرائحية والطائفية)، فإنهما يتقاطعان في كونهما يُنتجان هوية ضيقة موازية لهوية الدولة، مما يؤدي إلى ضعف الانتماء الوطني وتفتت الولاء وخلخلة مشروع الدولة الجامعة، وقد عبّر علي الوردي عن هذا الخطر بقوله:«المجتمع الذي تغلب فيه الطائفة أو العشيرة على الدولة،لا يمكن أن تقوم فيه عدالة ولا إصلاح»، وهي مقولة تصلح أن تكون مدخلًا لفهم كيف تتحول الهويات الجزئية من مصدر تنوع إلى أداة تعطيل لبناء الدولة .
فما مظاهر حضور هذه الظواهر في المجتمعات الناطقة بالحسانية؟ وكيف تتجلى في السياق الموريتاني خصوصًا؟ وهل يمكن تصحيح المظالم التاريخية دون الوقوع في فخ الهويات المتناحرة؟ وهل تبنّت الدولة منذ نشأتها استراتيجية قادرة على تفكيك هذا البناء التقليدي؟
الشرائحية والطائفية: بناء تقليدي في مواجهة الدولة الحديثة
عرفت مجتمعات الصحراء منذ القدم ظاهرة الشرائحية،حيث توزعت مكوناتها على أساس وراثي، ويبدو أن الشرائحية لم تكن حكرًا على الناطقين بالحسانية، بل كانت تطال المجتمع الزنجي في المنطقة المعروفة اليوم بموريتانيا، وكذلك في البلدان المجاورة، خصوصًا مالي والسنغال، بل إن التعامل مع الشرائحية في بعض تلك المجتمعات كان أكثر قسوة مما هو مألوف لدى الناطقين بالحسانية.
وترتكز الشرائحية — كما هو معروف — على منطق التوارث الاجتماعي: مهن تتناقلها الأسر، مناصب تُحجز لشرائح معينة، وفضاء اجتماعي مغلق يمنع الآخر من اختراقه. ويتكرّس هذا الواقع حين تتحول الانتماءات التاريخية إلى مرجعيات حديثة تُحدّد حظوظ الأفراد في الدولة، مع أن الدولة يفترض أن تقوم على مبدأ المواطنة الفردية التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
ولعل أخطر ما في الطائفية والشرائحية هو أنهما تُنتجان نظامًا داخليًا يصعب اختراقه، يكون الولاء فيه للطائفة أو الشريحة أكثر من أي شيء آخر، مما يجعل المعايشة والانسجام في أي بلد يضم طوائف وشرائح متعددة صعبًا إلى حد كبير، فضلًا عن عدم القدرة على إقامة دولة تحكم بالعدل ويتساوى أفرادها أمام القانون.
موريتانيا: الشرائحية بين الإرث التاريخي والمطالبة بالإنصاف
في السياق الموريتاني، تبرز الشرائحية كإحدى الحقائق الاجتماعية المتجذّرة، حيث يتكوّن المجتمع من شرائح متعددة، أبرزها تلك المنضوية تحت المكوّن الناطق بالحسانية، مثل: الزوايا، العرب، إيكاون، لمعلمين،الحراطين...
وطبعًا لم تُبنَ العلاقة بين هذه الشرائح على التكافؤ دائمًا،بل ظلت محكومة أحيانًا بتراتبية اجتماعية صارمة تغذيها الذاكرة التاريخية، وتتكفّل العادات المحلية بإعادة إنتاجها.
وسنركّز الحديث هنا على شريحة واحدة هي شريحة الحراطين، التي بدأت تعي موقعها الاجتماعي منذ السبعينيات وتحتج عليه، تحديدا مع ظهور حركة "الحر"سنة 1978، التي شكّلت نقلة في الخطاب الشرائحي داخل المجتمع البيظاني.
فأنتج ذلك التحرك خطابا طالب بالتحرر من الإرث الاستعبادي، وبالاعتراف بحقوق هذه الشريحة دون أن يخرجها عن المكون الرئيس الجامع للمجتمع الناطق بالحسانية ( البيظان)، ثم تطور الخطاب ليطالب بهويةمنفصلة مع الرعيل الأكثر راديكالية في مطلع الألفيةالحالية.
مما جعل ذلك الوعي المشروع، يتطوّر في بعض جوانبهإلى خطاب هويّاتي مغلق، ليكون عرضة للتسييس أو الاستخدام المصلحي، ثم بدا وكأنه نموذج قابل للاستنساخ مع بقية الشرائح الأخرى، الأمر الذي يُهدد بتحوّل الوطن إلى فسيفساء متنافرة، وهي المرحلة التي يعبر عنها الكاتب العربي عبد الرحمن منيف بـ"الانتحار البطيء" في قوله: «حين تنقسم الأمة إلى طوائف وشرائح متناحرة، فإنها تكون قد دخلت مرحلة الانتحار البطيء».
وهكذا، بدل أن يكون خطاب الحراطين أداة دمج، كاد أن يتحول في لحظات إلى خطاب فرز، لا سيما حين يُقابَل بالتجاهل أو الاستعلاء من قِبل النخب التقليدية.
غياب الرؤية الاستراتيجية وتنامي الخطابات الشرائحية
منذ تأسيس الدولة الموريتانية، لم تعمل على تبلور رؤية استراتيجية واضحة تُعنى بتوحيد النسيج الاجتماعي،ومعالجة الاختلالات الشرائحية المتجذّرة في المجتمع، رغم وجود عوامل حاسمة يمكن أن تستثمر في ذلك الصدد،من أهمها العامل الديني، واللغة الواحدة، والثقافة والعادات والقيم المشتركة، والوشائج الأسرية الضاربة في التاريخ.
كل هذا لم يُستثمر ضمن رؤية استراتيجية جادة تخلق هوية وطنية جامعة، بل كثيرًا ما تعاملت الدولة مع المسألة من منطلق الإنكار أو التواطؤ الصامت، مما أفسح المجال لظهور خطابات شرائحية متشددة.
وقد أدى هذا الغياب إلى تراكم الإقصاء والتهميش،وتحوّلت بعض الشرائح إلى كيانات تُجاهر بمظلوميتهاوتوظّف خطابها في الدعاية السياسية والضغط الاجتماعي، وهو ما بات يُهدد الانسجام الوطني.
حتى النظام التعليمي، الذي يُفترض أن يكون أداة دمج وصهر ثقافي، ظل يُكرّس الفرز بين الناطقين بالعربية وغيرهم. ولم تعرف موريتانيا مشروعًا يحمل رؤيةاستراتيجية واضحة تسعى إلى بناء هوية وطنية جامعة قبل "مشروع المدرسة الجمهورية" الذي طرحه النظام الحالي كأداة قادرة على صهر المكونات الوطنية ثقافيًا،وخلق هوية وطنية أكثر انسجامًا.
يُضاف إلى هذا المشروع ترسانة من القوانين التي تحرّم العبودية، وتجرّم الاسترقاق، وحزمة من البرامجالاقتصادية الاستعجالية التي تستهدف الفئات الأكثر تضررًا من الإرث الشرائحي، إلا أن هذه المشاريع كلها لم تقنع فئات واسعة تتوق إلى نتائج أكثر سرعة وحسما.
ضرورة الأخذ بالإجراءات الموازية لضمان سلامة الوطن
رغم أهمية المشاريع القائمة والاستراتيجيات الحالية، فإن نتائجها لن تظهر على المدى القصير، إلا أنه لا يمكن ترك المجال مفتوحًا لمن يستغل الشرائحية لأغراض ضيقة،ضاربا عرض الحائط بوحدتنا الوطنية، مما يحتّم الأخذ بإجراءات أخرى موازية تكون أكثر حزما تنص على تجريم كل أشكال الاستغلال الشرائحي، ويقصر الترافع عن الحقوق في هذا المجال على المؤسسات والمنظمات المصرح لها بذلك.
كما يجب تجريم استخدام الألفاظ والرموز والممارسات التي تُعيد إنتاج الشرائحية أو القبلية، باعتبار الأخيرة رديفة للشراحئية والظهير الحاضن لها.
ويقترح البعض إعادة النظر في آلية إثبات الهوية في البطاقة الوطنية، تتمثل في حذف الاسم العائلي والإبقاء على الاسم الشخصي واسم الأب فقط، لقطع الصلة مع الألقاب العائلية التي ظلت تكرّس التمايز الطبقي،وشهادة على صناعة التفاوت الاجتماعي، وقد استخدم الأتراك طريقة مشابهة لهذه الطريقة في القرن المنصرم مع بعض الهويات التي استقرت في الدولة التركية فسّرعت اندماجها وانصهارها في المجتمع .
وهكذا، نتبين أنّ مواجهة الشرائحية والطائفية معركة طويلة، لا تُخاض بالشعارات، بل بالمشاريع الوطنية الشاملة، وتتطلب الاعتراف بالمظالم، والسياسات المنصفة، والتعليم العادل، والقدرة على تفكيك البنى التقليدية التي تُعيد إنتاج التهميش، و الصرامة في تطبيق القانون، فالوطن يُبنى حين يتعلّم الجميع كيف يكونون سواسية، لا حين يتنازعون على من الأحق أو الأسبق، والهوية الوطنية لا تعني طمس التعدّد، بل تحويله إلى مصدر غِنَى داخل مشروع جامع يشعر فيه كل فرد أن الدولة تحميه ولا تُقصيه، وأن الانتماء للوطن لا للشرائحوكما قال المناضل العظيم مانديلا: «إذا كان الناس قد تعلّموا الكراهية، فيمكن تعليمهم الحب».
يحيى ولد البيضاوي




.jpeg)





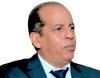







.jpeg)