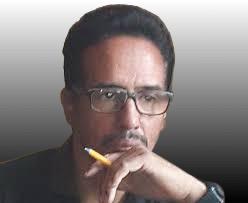
تُجمع كل الموسوعات والقواميس المعتمدة (موسوعة المفاهيم الإسلامية، موسوعة العبودية والتحرر، قاموس Black’s Law dictionary ) على أن العبودية وضعية يكون فيها الإنسان مسلوب من جميع حقوقه، لكن ذلك السلب تتغير دلالاته وممارساته حسب السياق الزمني والاقتصادي وحتى الاجتماعي، فالجمع بين الاستغلال المفرط والعنف الجسدي واللفظي ضد العبيد من أهم سمات مجتمعات القرون الوسطى، وإن كانت ثمة بعض ترسبات تلك الحقب في واقعنا المعاش تظهر بين الحين والآخر، وبدوافع مختلفة في مجتمع مازال ارتباطه بالماضي شبه عضوي نظراً لبدائية وسائل الإنتاج.
تلك الترسبات هي التي دفعت "باللَّونية" إلى المشهد السياسي والحقوقي، بقوة مستمدة شرعيتها من ذاكرة لا تزال تئن تحت وطأة جراح مخلفاتها ماثلة للعيان، والحق أن أنين الذاكرة الجمعية أخفى حقيقة عبودية أخرى يُعد ضحاياه بالملايين حول العالم، نظرا لقواسمها المشتركة مع سابقتها في العديد من المسائل، مثل الاستغلال وسلب الإرادة، ناهيك عن الابتزاز الذي يُعد من أهم مظاهر هذا الصنف من الاسترقاق، وإن كان في الغالب يتم عبر قوى ناعمة تتحول بسرعة إلى قوة قاهرة بأساليب لا تظهر للعن إلا في حالات نادرة.
ولعل هذا هو السر في كونها لم تحظ بالاهتمام ذاته في القوانين الدولية،التي يعود تجريمها للعبودية التقليدية إلى بداية القرن 19م وتحديدا في العام 1807م، الغريب أن الأمم المتحدة لم تُصنف -حتى الآن- هذا النوع من الرق، رغم ما نتج عنه من اختلالات عميقة، عصفت بكيان مجمعات لها تاريخها العريق في الاستقرار السياسي، واحترام حقوق الإنسان، صحيح أن مصلحة استخبارات دول قوية، تحول دون تصدر هذا المفهوم للوجهات الإعلامية، نظرا لما يترتب عليه من قلب مخيف للهرم الاجتماعي، قد يضع ما نعتبرهم زعماء في خانة هذا الرقيق الجديد.
إن سرعة انتشار هذا الصنف من العبودية طرح إشكالات نفسية وقانونية كبرى في التعامل مع الهُوية الاجتماعية المزدوجة لأشخاص يُصنفون افتراضياً في قائمة الأرقاء، نتيجة لأخطاء بدوافع مختلفة، فالأمر لم يعد يحتاج كما كان إلى إكرارهات بدنية ورحلات مُضنية عبر مئات الأميال علىمسارات طرق قوافل الرقيق إلى أسواقه المعروفة، بل اختصر على وسائل تكنولوجية منتشرة وبسيطة الاستخدام، قد تجعل من مجتمعات وازنة في الواقع،وبكل سهولة، سعلة للبيع في أسواق النخاسة الافتراضية، فسهولة الحصول على الهواتف الذكية والجهل بأهمية الحفاظ على المعلومات الخاصة، والفضولية الزائدة عند البدو، كلها عوامل اجتمعت لتجعل الموريتانيين على قائمة هذا الصنف من الرقيق.
لا تُمكننا المعطيات المتاحة من تخمين عدد الأرقاء الافتراضيين في موريتانيا، وإن كانت ثمة مؤشرات تؤكد أن عدد هم في تزايد مخيف، نظرا لشيوع الجهل، وعدم فهم الأخطار المترتبة على نشر المعلومات الشخصية ، أو بعبارة أدق فإن مجتمعنا لا يُقيم وزناً لأمن المعلومات التي يبدأ اختراقها عبر سلسلة من الوسائط تركز على استهداف الأرقاء الجدد من خلال قرصنة معلوماتهم الخاصة، بواسطة روابط مجهولة المصدر على فيس بوكووات ساب...، وبعد الضغط عليها يستطيع "الهاكرز" التحكم في هواتف الضحايا وبسهولة، دون أ يدركوا أن مكالماتهم حول مواضيع حساسة وغرف نومهم مراقبة من طرف هواتف موقنين أنها خارج الخدمة.
بدأ المجتمع ينتبه لمخاطر التكنولوجيا، بعد تسريبات صوتيات ومقاطع مصورة سببت إحراجاً لرجال مشهورين يعملون في حقليْ السياسة والإعلام، وإن كان البعض يرى أن الاستخبارات أقحمت نفسها في تجارة هذا النوع من الرقيق بواسطة نشر خصوصيات صادمة بهدف إلهاء الرأي العام عن قضايا بعينها، كما حدث مع واجهة المعارضة الديمقراطيةوالسناتور وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بيد أن ظاهرة الصمت المطبق عند أشخاص بعينهم والتغيير المُفاجئ في المواقف المتشددة من النظام، وكذا عدم صرامة السلطات -غير المفهومة- إزاء ملفات بعينها، لا يعدو -حسب مهتمين- كونه صنف أخر من عمليات استفزاز خفية على علاقة وثيقة بظاهرة الاسترقاق الافتراضي، ثمة حالات عديدة لازال أصحابها تحت تأثير الصدمة، وقد يفقدون صبرهم في الأخير، لكن مُحاولة التهرب مما نسميه بــ "سُخرة الابتزاز" ، سيُدخلهم في الدوامة ذاتها، وهكذا يستطيع الرق الافتراضي إنتاج نفسه عبر منظومة ابتزازيةمزمنة بالغة التقعيد تُحيطها حواجز أُسست على جدران من الخوف والصمت المحير.
د. أمم ولد عبد الله




.jpeg)








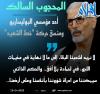




.jpeg)