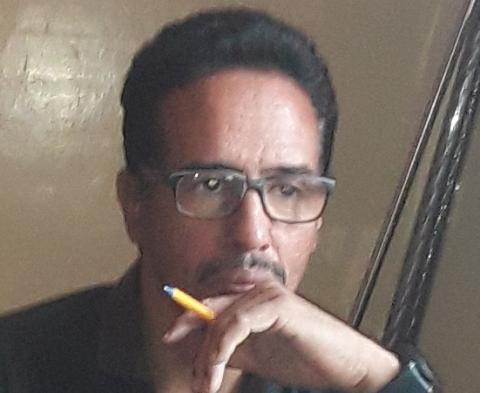
قبل الخوض في التفاصيل لابد من تحديد مفهوم إجرائي للكتلة الانتخابية في موريتانيا، خصوصاً وأن معظم الباحثين في هذا المجال لم يعطوا تعريفاًواضح المعالم للكتل الانتخابية، فقد ظل هذا المفهوم متروكاً للدعاية، دون وضع معايير محددة لا من قبل السلطة ولا من الأحزاب السياسية؛ وإن كان هناك نوع من التحديد الخجول عبر ما يعرف بالوحدات الانتخابية، ومع ذلك يبقى عددها غير مؤثر بشكل فعال في موازين القوى الناخبة، مما يحتم على المهتمين المجال والفاعلين فيه تحديد مفهوم للكتل الانتخابية نظرا لتأثيراتهاالمباشرة على القرار السياسي في البلد.
ثمة محددات نستطيع، في نظري، البناء عليها لوضع مفهوم للكتلة الانتخابية في موريتانيا، يتعلق الأمر أولا بالعدد ثم بوحدة الكلمة، ناهيك عن التقاطع في الكثير من المشتركات الأخرى، فمن حيث العددُ لا ينبغي أن يقل عددها عن ثلاثة آلاف ناخب، على اعتبار أن هذا الرقم باستطاعته حسم الفوز في أي انتخابات بلدية ريفية على مستوى الوطن، وبإمكانه التأثير بشكل جلي في نتائج الاستحقاقات النيابية في معظم المقاطعات.
والحق أن الأنظمة أدركت مدى تأثير هذه الكتل وضرورة التحكم فيها مع بداية التجربة الديمقراطية في موريتانيا، حيث كان النظام الحاكم وقتها يعتمد على القبائل ذات الثقل الديموغرافي لإنشاء تجمعات انتخابية تعتمد في تشكيلتها على سردية وحدة الأصل ونبله، مدعوما ببعض الامتيازات التي توفرها الدولة لتضمن استمراريتها على مقاييس يبدو أنها وصلتلطريق مسدود؛ مع تزايد الوعي في أو ساط الشباب وبين ساكنة المدن الكبرى، التي أصبحت مصدر قلق جدي لمنظري التركيز على القبيلة داخل الحزب الحاكم في إنشاء تجمعات انتخابية وازنة تَسهل قيادتها بحكم نجاعة هذا الأسلوب في الأوساط الريفية.
لا يمكنني في هذه الأسطر سرد كرونولوجية هذا الانتجاع البالغ التعقيد في الكثير من مراحله وتمظهراته، لكن الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت أدوارا مهمة في التأثير على وُجهات هذا الانتجاع، الذي يبدو أنه لم يكن يخضع للمنطق الاستراتيجي بقدر تأثره بردات فعل غيرمحسوبة في معظمها، تهدف للانتقام في إطار حسابات ضيقة بين مجموعات تقليدية متصارعة على النفوذ سواء داخل الأغلبية أو خارجها.
انتقلت تلك الكتل خلال العقد المنصرم من الإطار القبلي الضيق إلى أحلافسياسية تضم قبائل وأثنيات عديدة، ما أتاح فرصة لرجال الأعمال أن يتصدروا المشهد السياسي، مشكلين بذلك الخيط الناظم للكتل السياسية في البلد، هذا المُعطى الجديد فرض نفسه على أصحاب القرار الذين،اعتمدوا مقاربة من شقين يركز أولها على توزيع المناصب وبعض الامتيازات على واجهة تلك التكتلات لضمان ولائها، بينما تكفل رجال الأعمال بمنح الواجهة الأخرى في هذه الكتل قروضاً سخية تزداد أرقامها مع كل موسم انتخابي.
هذه المقاربة حملت في طياتها كل العوامل المحفزة على نزوح هذه الكتل في أوقات حرجة، وعلى أساس إعادة تموقعها داخل خريطة متحركة يمكننا تصنيف هذا النزوح إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يمثل أولها النزوح داخل الكتلة الواحدة المحسوبة على الأغلبية في محاولة للتأثير على التراتبيةداخلها، متسببة في انضمام مئات الناخبين إلى مرشحين منافسين للنظام، أما الصنف الثاني فيشمل كل أنواع الفعل السياسي المغاضب؛ والذي غالبا ما يؤدي لنزوح كتل وازنة في أوساط المغاضبين أثناء الحملات الانتخابية، وتُعد الكتل الكبرى في الخارج خاصة في أمريكا الشمالية وإفريقيا أهم مظاهر هذا الخلل الناجم عن حركة أفقية لها تأثيرها القوي في القوة الناخبة في موريتانيا، حيث تمثل هذه الأخيرة إحدى أهم تجليات هذا النزوح الحرج،ببعديه الزماني والمكاني.
يضع هذا الواقع المركبة المشرفين على حملة فخامة الرئيس أمام تحديات صعبة، تحتم عليهم أن يدركوا أن التعامل مع هذه الظاهرة البالغة التعقيد يحتاج إلى طرق غير تقليدية، خصوصا وأن أساليب التأييد المعلن تأخذ مظاهر خداعة؛ قد لا تعكس بالضرورة حقيقة خارطة تتغير بتأثيرات افتراضية مفصولة عن الواقع في معظم مراحل تطورها، ما يعني أن الهدوء المعلن ليس إلا مظهراً من مظاهر النزوح الحرج، لكن ضجيج حركته لا يسمع إلا في عوامل افتراضية؛ قد لا تثير اهتمام جيل الستينيات من القرن الماضي الذي يتولى الإدارة الفعلية للحملة الانتخابية لفخامته.
د. أمم ولد عبد الله




.jpeg)








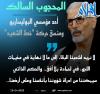




.jpeg)