
ليست الأزمة المالية اليوم مجرد اضطراب سياسي عابر، بقدر ما هي انكشاف تدريجي لواقع دولة فقدت أدواتها الرمزية قبل أن تنهار مؤسساتها الصلبة، وتلاشت قدرتها على تمثيل نفسها داخليا وخارجيا. فمنذ ما يزيد على عقد من الزمن، ومع توالي الانقلابات العسكرية، وتفكك البنى الحزبية، وتآكل الحضور الفعلي للدولة في شمال البلاد ووسطها، باتت مالي تتجه بخطى متسارعة نحو نموذج الدولة الفاشلة غير المعلنة، أي نحو كيان سياسي يحتفظ بمظهر السيادة، لكنه يفقد جوهرها، ويتحول من مركز قرار إلى هامش منفعل تدور حوله أطراف متعددة المصالح.
رغم ما تبديه السلطات الانتقالية من توجه نحو شراكات أمنية جديدة، خاصة مع روسيا وتركيا، فإن الواقع يظهر تصدعا بنيويا يتجاوز الأبعاد العسكرية نحو أزمة مركبة في الشرعية والسيادة. فالمشكلة لم تعد في غياب الاستقرار فحسب، بل أيضا في غياب أي أفق جامع لإعادة تأسيس الدولة كمجال مؤسسي توافقي، حيث أن مالي أصبحت حبيسة حلقة مفرغة من الانقلابات والولاءات الخارجية، تحت رحمة نخبة عاجزة عن إنتاج إجماع داخلي أو تمثيل اجتماعي فعال، مما جعل مشروع الدولة الوطنية يتحول إلى مجرد وهم رمزي لا يسنده الواقع. وعلى هذه الخلفية، تنفتح البلاد على جميع احتمالات التفكك والتدويل، في لحظة إقليمية شديدة السيولة والاضطراب.
أولا: الدولة كجغرافيا فاقدة للسيادة
إذا كانت الحدود تعرف نظريا بوصفها تجليا لمفهوم السيادة الحديثة، فإن دولة مالي اليوم تجسد بامتياز نموذج "الدولة الحدودية الفارغة"؛ أي الدولة التي تحتفظ بخريطة سياسية معترف بها دوليا، من دون أن تقترن هذه الخريطة بسيطرة فعلية على المجال الترابي، حيث أن مساحات واسعة من الأراضي باتت تخرج من حين لآخر عن سلطة المركز، لتتم إدارتها فعليا من قبل فاعلين غير دولتيين، من ضمنهم جماعات جهادية وحركات انفصالية، وشبكات التهريب العابرة للحدود.
ولا تقتصر خطورة هذه الوضعية على غياب الدولة، بل على تمأسس سلطات بديلة تنتج الأمن والاقتصاد والعدالة وفق منطقها الخاص، الذي غالبا ما يكون مناهضا لمفاهيم الدولة الحديثة. وفي ظل هذا المشهد، تكاد الدولة المالية تنحصر في أطراف العاصمة وفي بعض المحاور الحيوية، التي لا تدار إلا بفضل دعم خارجي متقطع.
وقد ازدادت حدة هذا الانفصال بفعل تراجع التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وتفكك البنية الإدارية المحلية، الأمر الذي أوجد فراغا مؤسسيا تستثمره الفواعل غير النظامية. وقد تحول هذا الفراغ من ظاهرة مؤقتة إلى بنية دائمة تعيد إنتاج نفسها، في غياب أي مسار لإعادة بسط السيادة الفعلية على المجال الوطني.
تشير هذه اللحظة إلى ما يمكن تسميته بـ"نهاية الجغرافيا السيادية"، حيث لم تعد الدولة تحتكر المجال، بل تخلت عنه لصالح جغرافيا بديلة تحكمها بنيات لا دولتية، ذات منطق مختلف في إدارة السلطة والمعيش اليومي. هذه البنيات - من جماعات مسلحة، وزعامات محلية، وشبكات تهريب - لا تعمل ضمن إطار مؤسسي واضح، بل تؤسس لسلطات أمر واقع تتغذى من ضعف المركز، وتعيد إنتاج السيطرة من خلال مزيج من العنف الرمزي والمادي، ومنطق الولاء المحلي بدل الانضباط القانوني.
ويمكن القول بأننا أمام تفكك لا يعبر عن انهيار مفاجئ، بل عن تآكل بطيء ومتراكم، يحول السيادة من مفهوم قانوني إلى هيكل فارغ يتم ملؤه بشروط الواقع الميداني. ولا يعني هذا النمط من التحول فقط غياب الدولة، وإنما يعبر أيضا عن تحول الفاعلين غير الرسميين إلى صناع قرار حقيقيين، يفرضون قواعد اللعبة في مناطق واسعة من البلاد، وسط صمت المركز أو عجزه.
ثانيا: السلطة الانتقالية كمنظومة تصادم لا حكم
تتسم اللحظة الراهنة في باماكو بغياب مزدوج: غياب المشروع السياسي من جهة، وغياب مركز فعلي للسلطة من جهة أخرى، ذلك أن السلطة الانتقالية، التي نشأت إثر انقلاب عسكري، باتت اليوم ساحة لصراع داخلي حاد بين جناحين رئيسيين: جناح الرئاسة الذي يقوده العقيد آسيمي غويتا، وجناح وزارة الدفاع المتمحور حول العقيد ساديو كامارا، والذي يحظى بدعم روسي متشعب يشمل الجوانب الاستخباراتية والتجارية والأمنية.
وقد تجاوز هذا الانقسام مستوى التنافس السياسي إلى مستوى التفكك المؤسساتي، حيث انعكس مباشرة على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية التي لم تخضع بعد لأي عملية إصلاح أو إعادة هيكلة شاملة. فبدل أن تكون القوات المسلحة ركيزة للانتقال، تحولت إلى مسرح لتجاذبات النفوذ، ما قوض دورها كضامن للاستقرار.
ويكشف هذا الصراع كذلك عن غياب الرؤية الاستراتيجية لبناء مؤسسات مدنية حقيقية، وتردي الإرادة السياسية للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة بناء الدولة. ولم يعد التجاذب بين مراكز القوة تعبيرا عن تنوع في الخيارات، لأنه أصبح مرآة لأزمة بنيوية تتهدد كيان الدولة في جذره، بما يجسده من أزمات في التخطيط، وفي الشرعية، وفي القدرة على إنتاج الإجماع الوطني.
ومما يزيد الأزمة تعقيدا هو الانكماش المتسارع الحاصل في الفضاء السياسي، من خلال حل الأحزاب السياسية والتضييق المتصاعد على النقابات والمنظمات المدنية، مما أفرغ الحياة السياسية من مضمونها التعددي، وكرس هيمنة أمنية مغلقة. وبهذا، تحولت السلطة في باماكو من إطار تمثيلي يعكس تعدد المصالح إلى طيف أمني منزوع من أي قاعدة مجتمعية أو أفق شرعي مستدام.
وفي الواقع، فقد ترتبت على هذا الانغلاق مخاطر استراتيجية، أبرزها تقويض فرص إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعميق العزلة بين السلطة والمجتمع، الأمر الذي يبقي الدولة رهينة لأجهزة القوة، لا باعتبارها أداة في خدمة المشروع الوطني، وإنما بوصفها البديل الوحيد للحكم، في غياب المؤسسات الشرعية والتوافقية.
ثالثا: الدعم الروسي والتركي بين المظهر والمأزق
رغم الخطاب المهيمن حول استبدال النفوذ الفرنسي المتراجع بنفوذ روسي صاعد، فإن الوقائع الميدانية في مالي تكشف عن مأزق استراتيجي مزدوج، لا يتعلق فقط بفشل الفاعلين الجدد في استعادة الأمن، بل أيضا في طبيعة تدخلاتهم التي غالبا ما تعيد إنتاج التبعية بواجهات مختلفة:
• دخلت روسيا إلى المشهد المالي بقوة عبر ذراعها الأمني (مجموعة فاغنر)، مقدمة خدمات تدريب وقتال وتأمين وحماية للمؤسسات الانتقالية، لكنها فعلت ذلك من خارج أي إطار مؤسسي ثابت أو اتفاقات معلنة وشفافة. وهذا النمط من التدخل، القائم على الترتيبات الرمادية، يكرس نموذج الدولة الأمنية الهشة، المعتمدة على فاعلين خارجيين أكثر من اعتمادها على مواطنيه، بدل أن يسهم في إعادة بناء الدولة؛
• من جهتها، دخلت تركيا من بوابة التدريب وبناء القدرات، مركزة على استثمارات ناعمة في مجالات التعليم والخدمات، ومحاولة فتح قنوات اقتصادية جديدة. إلا أن تحركاتها ما تزال محدودة من حيث الانتشار والعمق، وتفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية التي تؤهلها لملء الفراغ الجيوسياسي الذي خلفه الغرب. وبالتالي، بقي دورها محصورا في مواقع قابلة للربح السياسي أو الرمزي، من دون أن تتحول إلى شريك فعلي في إعادة بناء الدولة أو في مأسسة الأمن.
ضمن هذا السياق المركب، يصبح الوجود الخارجي جزء من إدامة الأزمة لا من حلها، ويغدو الدعم الخارجي غطاء لاستمرار بنية سلطوية هشة، يحتمي كل من الفرقاء المتنازعين داخلها بحليف أو بحلفاء خارجيين، بدل أن تبني قاعدة تمثيل داخلي فعالة. مما جعل الأمر يبدو أقرب إلى أزمة تموقع أكثر من كونه شراكة، ومظهر من مظاهر إعادة تشكيل خارطة النفوذ الدولي في فضاء الساحل من دون التزام فعلي بإعادة إنتاج الدولة الوطنية.
رابعا: الأثر الإقليمي .. ارتدادات الأزمة على المحيط الحدودي
ليست دولة مالي جزيرة معزولة عن محيطها، بل إنهاتشكل في وضعها الراهن بؤرة تصدع مفتوحة على حدود يفوق طولها ألفي كيلومتر مع موريتانيا، وتمر عبرها تفاعلات بشرية معقدة بفعل تشارك الإثنيات والروابط القبلية. ولذلك، فإن الأزمة المالية الراهنة لا تهدد الداخل المالي فقط، بل إنها تلقي بظلالها الثقيلة على أمن واستقرار الجوار، وفي مقدمته موريتانيا، خصوصا حين ننظر إليها من زوايا متعددة:
• التهديد الأمني المباشر: من خلال تزايد نشاط الجماعات المسلحة المنتمية إلى جبهة تحرير ماسينا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المناطق المحاذية للحدود، مع تسجيل اختراقات باتجاه العمق الحدودي الموريتاني، وتحول بعض المسالك التقليدية إلى ممرات للتهريب والتسلل، مما يفرض إرباكا أمنيا ويزيد العبء على الأجهزة الحدودية؛
• التهديد الاجتماعي والإنساني: عبر تزايد موجات النزوح القادمة من وسط وشمال مالي، وتدفقها على المناطق الشرقية من موريتانيا، حيث تجد الدولة نفسها أمام معضلة إنسانية مركبة تتمثل في استيعاب مئات آلاف من اللاجئين في بيئات فقيرة أصلا، وتفادي توترات محتملة بين السكان المحليين والنازحين في ظل شح الموارد والخدمات؛
• التهديد الجيوستراتيجي: من خلال تفكك المنظومة الجيوسياسية التقليدية على الحدود، وتآكل الحواجز السيادية بين مالي وموريتانيا، الذي يفتح المجال أمام تدفقات غير منضبطة للسلع، والسلاح، والأفكار المتطرفة والأفراد المتطرفين. وفي ظل غياب تنسيق أمني إقليمي فعال، تصبح الحدود أكثر هشاشة، وقد تتحول في لحظة فراغ سياسي إلى مجال للتدخلات الخارجية أو لنشوء ترتيبات أمنية جديدة تفرض من خارج السياق الوطني.
وبالنظر للهشاشة المتزايدة التي تتسم بها المناطق الحدودية بين مالي وموريتانيا، فإن أي انهيار إضافي في البنية السيادية لمالي لن يكون مجرد أزمة محلية، وإنما سيترجم مباشرة إلى تهديد فعلي للأمن الموريتاني. حيث أن موريتانيا، بوصفها دولة ملاصقة ومتداخلة إثنيا واجتماعيا مع مالي، ستجد نفسها في موقع لا يحتمل فيه الحياد السلبي، مما قد يضطرها إلى تبني خيارات استراتيجية دفاعية واستباقية، تتجاوز منطق الحذر التقليدي، لتأمين مصالحها الحيوية، وإعادة تعريف دورها الإقليمي في ظل فراغ الجوار وانفلاته.
خامسا: استشراف السيناريوهات
يتأرجح مستقبل دولة مالي بين ثلاثة مسارات استراتيجية رئيسية، تختلف في منطقها التحليلي، وفي مآلاتها المتوقعة على المديين القصير والمتوسط. وتستند هذه السيناريوهات إلى تقاطعات متعددة بين عناصر القوة الميدانية، وطبيعة التفاعلات داخل النخبة الحاكمة، واستجابات المجتمع المحلي، إضافة إلى مواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين. فكل سيناريو لا يقرأ بوصفه نتيجة خطية لتطورات داخلية فحسب، بل كمسار متشكل ضمن ديناميكيات مركبة لتآكل الشرعية، وانسداد الأفق المؤسسي، وتضارب مشاريع السيطرة والنفوذ.
ولا ينفصل تحليل هذه السيناريوهات عن الإطار النظري للدولة الهشة، الذي يعتبر أن مؤشرات الفشل لا تتجلى فقط في غياب الأمن والخدمات، بل في العجز عن إنتاج التمثيل والشرعية واحتكار العنف المشروع. كما أن العودة إلى النماذج المقارنة في إفريقيا جنوب الصحراء، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، تتيح فهما أعمق لكيفية تفاعل الديناميكيات المحلية مع التوازنات الإقليمية، وكيف يمكن للهشاشة البنيوية أن تتحول إلى نقطة جذب لتدخلات دولية تعيد تشكيل المجال السيادي وفق مصالحها.
ضمن هذا الإطار، يصبح استشراف مستقبل مالي محاولة لتحليل الاحتمالات من داخل البنية، لا من خارجها؛ أي عبر فهم منطق الأزمة بوصفها عملية تراكمية وليست حادثا منفردا، وبوصف الدولة ساحة اشتباك رمزي ومادي بين قوى متعددة، وليست كيانا متجانسا يمكن إصلاحه بتدخل إداري أو عسكري سريع.
السيناريو الأسوأ: تفكك السلطة وانزلاقها نحو التشظي الداخلي
يفترض هذا السيناريو أن تفكك مركزية السلطة في باماكو سيتواصل بوتيرة متسارعة، مع تعمق التصدعات داخل المؤسسة الحاكمة وتزايد انعدام الانسجام بين الأجهزة السياسية والعسكرية. وفي غياب قيادة موحدة أو مشروع وطني جامع، تتحول البلاد إلى ساحة صراع داخلي مفتوح، قد يتخذ طابعا دمويا خصوصا إذا انهارت ترتيبات الضبط التي توفرها القوى الحليفة، وعلى رأسها روسيا وتركيا.
وضمن هذا المناخ المأزوم، تغدو مناطق واسعة من الشمال والوسط والمناطق المحاذية للحدود مع موريتانيا والسنغال، عرضة للاختراق من قبل جماعات عابرة للحدود، تتغذى من هشاشة الدولة المركزية وتبني على التناقضات المحلية سلطة موازية، مما يسمح بتشكل واقع سياسي جديد، تكون فيه الدولة المركزية مجرد كيان رمزي، في حين يتم إنتاج السلطة بشكل فعلي في الأطراف من قبل قوى محلية، دينية أو مسلحة، تفرض أنماط حكمها وتوزيعها للموارد.
ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان ما أشار إليه برتراند بادي في تحليله لتحولات الدولة الحديثة، حين اعتبر أن أخطر أشكال الهزيمة هي تلك التي لا تأتي من الخارج، وإنما من الداخل، عندما تفقد الدولة قدرتها على احتكار العنف، وتمثيل المجتمع، وإنتاج المعنى السيادي. فالخطر هنا لا يكمن فقط في الانهيار المؤسساتي، بل في ظهور منظومات بديلة تملأ الفراغ، وتعطل أفق الإصلاح لعقود قادمة.
السيناريو المتوسط: استمرار إدارة الفوضىوالهشاشة
يفترض هذا السيناريو استمرار النظام الانتقالي في الحكم، لكن ضمن صيغة هشة وغير مستدامة، قائمة على دعم خارجي محدود، لا يرافقه أي ضغط فعال لإحداث إصلاحات هيكلية حقيقية. في هذا الوضع، تتجه البلاد إلى نمط من "الاستقرار السلبي"، حيث يتم احتواء الفوضى دون معالجتها، ويتم الاكتفاء بإدارة الأزمة بدل السعي إلى تفكيكها.
ويتمثل هذا النمط في ترتيبات محلية مؤقتة، يعقدها الجيش مع زعامات تقليدية أو قادة جماعات مسلحة، بما يحافظ على الحد الأدنى من السيطرة الشكلية، دون أن ينتج سياسات وطنية شاملة أو تمثيلا حقيقيا لمكونات المجتمع. وتستمر بذلك الدولة في أداء وظائفها الشكلية فقط، بينما تتآكل قدرتها على الفعل السيادي وعلى توجيه المسار السياسي.
يعرف هذا الوضع في الأدبيات الأمنية، بما يسمى بـ "الحكم في المنطقة الرمادية"، حيث تسود أنماط إدارة هجينة وغير رسمية، تضع الدولة في موقع الطرف المتعايش مع تعددية مراكز السلطة بدل أن تكون الإطار الناظم لها. وبالتالي نكون في هذه الحالة أمام سيناريو الركود المقنن، الذي يراكم الهشاشة تحت مظلة من الاستقرار المخادع.
السيناريو الإيجابي: استعادة المبادرة عبر انتقال تفاوضي مدعوم دوليا
يمثل هذا السيناريو المسار الأكثر نضجا على المستوى السياسي، والأعلى كلفة من حيث التنازلات التي يتطلبها من جميع الأطراف، لكنه أيضا هو الأكثر انسجاما مع منطق إعادة تأسيس الدولة على أسس تمثيلية ومتعددة الأقطاب. يستند هذا الخيار إلى تدخل إقليمي أو دولي غير وصائي، على شكل توجيهي، يرمي إلى دفع الفرقاء الماليين نحو إطلاق عملية حوار وطني شامل، لا يقتصر على العسكريين والمدنيين في نخبة العاصمة، بل يدمج الفاعلين من مختلف الجهات والمكونات.
ضمن هذا الإطار، تتاح إمكانية بلورة عقد اجتماعي جديد، يتجاوز منطق الغلبة السياسية أو العسكرية، ويؤسس لمسار انتقالي تتولاه حكومة تمثيلية واسعة القاعدة، تمنح لها صلاحية تفكيك بنية الأزمة بدل الاكتفاء بإدارتها. ويتم التوجه نحو التأسيس للامركزية سياسية وإدارية حقيقية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لهذا التحول، بما يتيح إعادة توزيع السلطة والثروة على نحو يعيد بناء الثقة بين المركز والأطراف، ويقلل من قابلية الأطراف للتجييش أو الانفصال.
يجد هذا السيناريو مرجعيته النظرية في أدبيات إعادة بناء الدولة بعد النزاعات، كما صاغها فرانسيس دنغ وبيتر درايسباك وآخرون، والتي تؤكد أن التعافي لا يكون تقنيا أو أمنيا فقط، وإنما هو أيضا سياسي وتمثيلي في جوهره، يقوم على الاعتراف بالتعدد وتحييد منطق الاحتكار الأحادي للسلطة.
خاتمة
ما نشهده اليوم في مالي لا ينبغي اختزاله في فشل الدولة في استعادة السيطرة على مجالها الترابي، لأنهيمثل لحظة تفكك بنيوي لمفهوم الدولة ذاته، وهي لحظة تتجاوز الانهيار الأمني لتلامس أسس التمثيل والشرعية والمعنى؛ تتحول الدولة المالية تدريجيا من فاعل مركزي يضبط إيقاع المجال إلى ساحة مفتوحة لصراع الوكلاء والمصالح، ومن مصدر قرار إلى كيان هش تعاد صياغته من الخارج، وتدار شؤونه عبر شبكات متداخلة من النفوذ المسلح، والدعم الخارجي، والسلطة المؤقتة التي تطول دون أفق واضح.
في مواجهة هذا التحول البنيوي، لا تكفي المقاربات الأمنية مهما بلغت فعاليتها، حيث تقتضي اللحظة مشروعا سياسيا مؤسسا، يعيد بناء العقد الاجتماعي من القاعدة، ويستعيد التمثيل الشعبي كمصدر شرعية، ويقطع مع منطق التمديد الزمني لسلطة انتقالية باتت عبئا على المستقبل أكثر من كونها جسرا إليه. ومن دون هذا التأسيس، ستترسخ ملامح التشظي النهائي، وتدخل مالي في طور من السيولة المؤسسية قد لا يمكن احتواؤه ضمن حدودها فقط.
إن استمرار هذا المسار لا ينذر بانهيار داخلي معزول، وإنما يهدد بتأثير ارتدادي يطال عموم الساحل، ويضع الدول المجاورة أمام اختبارات مصيرية. وتوجد موريتانيا في مقدمة هذه الدول، لأنها تجد نفسها على تماس مباشر مع هذا التفكك، بحكم الامتداد الحدودي الواسع، والترابط الاجتماعي العابر للدولة، والتشابك في مسارات اللجوء، والجريمة، والتطرف. ومن ثم، فإن السؤال حول مصير مالي لم يعد سؤالا ماليا صرفا، لأنه أضحى أيضاسؤالا إقليميا تمس إجابته صميم الأمن الموريتاني، وتفرض إعادة تعريف أولويات الدولة، وخياراتها الجيوسياسية، وحدود قدرتها على الاستمرار كفاعل مستقل في بيئة إقليمية متصدعة.
مركز أوداغست للدراسات الإقليمية




.jpeg)








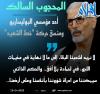




.jpeg)