
تحولت منطقة الساحل الإفريقي خلال العقدين الأخيرين إلى إحدى أكثر الساحات حساسية وتعقيدا في الجغرافيا السياسية العالمية. فعلى امتداد هذه الرقعة المترامية بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر، تتقاطع رهانات أمنية واقتصاديةوعرقية، ضمن سياق يتسم بتآكل الدولة الوطنية، وتنامي الجماعات المسلحة، وعودة التنافس الدولي بين القوى الكبرى. وفي صميم هذا الحقل الجيوستراتيجي المتشابك، تجد موريتانيا نفسها أمام تحد مزدوج: الحفاظ على استقرارها الهش نسبيا، وفي الوقت ذاته، صياغة دور إقليمي يراكم النفوذ بدل الاكتفاء بمجرد التكيف مع المتغيرات.
لقد أفضى الانسحاب الفرنسي التدريجي من بعض دول المنطقة، وصعود الحضور الروسي على أنقاضه، وتزايد النفوذ التركي والخليجي، إلى إعادة تشكيل موازين القوى في الساحل، وهو ما يضع موريتانيا أمام لحظة مفصلية تحتم الانتقال من منطق الحذر الدبلوماسي إلى عقلية المبادرة الاستراتيجية. فبينما راهنت الدولة الموريتانية تاريخيا على التوازن وتجنب الاستقطاب، باتت ضرورات السيادة والمصلحة الوطنية تتطلب اليوم انخراطا أكثر تصميما في هندسة التوازنات الجديدة.
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن موريتانيا، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، واستقرار نسبي، وخبرة تراكمية في مقاربة القضايا الساحلية، مرشحة للعب دور يتجاوز الحضور الرمزي إلى صناعة النفوذ. لكن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق دون قراءة معمقة لطبيعة الاستراتيجيات الكبرى المتصارعة في الإقليم، وتشخيص دقيق لمواطن القوة والضعف في المقاربة الموريتانية، واقتراح مسارات عملية للتحول من التموقع الدفاعي إلى الفعل المؤثر.
تهدف الورقة إلى تقديم تحليل استراتيجي لتعدد الاستراتيجيات الكبرى في منطقة الساحل، واستكشاف خيارات موريتانيا ضمن هذا السياق، من خلال معالجة ثلاثية الأبعاد:
● خريطة التنافس الدولي والإقليمي في الساحل؛
● حدود وممكنات التموقع الحذر الموريتاني؛
● السيناريوهات الواقعية لبناء نفوذ موريتاني استراتيجي في الإقليم.
المحور الأول: تعدد الاستراتيجيات الكبرى في الساحل
تعيش منطقة الساحل لحظة استراتيجية استثنائية، تتقاطع فيها مفاعيل التغيير الجيوسياسي، وانكفاء القوى التقليدية، وصعود فاعلين غير تقليديين بأساليب هجينة. فقد تحول الساحل من مجرد حزام أمني هش يطوق شمال إفريقيا إلى فضاء مفتوح لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية. ولا يمكن فهم هذا التحول من دون التوقف عند تعدد الاستراتيجيات الكبرى التي تتنازع النفوذ في الإقليم، وكشف طبيعة الأدوات المستخدمة، وطبيعة الغايات المتوخاة، والحدود الجديدة لتوازنات القوة.
ضمن هذا السياق، شكلت الانسحابات المتوالية لكل من فرنسا والولايات المتحدة من مالي وبوركينا فاسو ثم النيجر حدثا فارقا في مسار التنافس الدولي، حيث فقدت باريس وواشنطن – تباعا – القدرة على الصمود أمام السياقات الجديدة التي فرضتها الانقلابات العسكرية، وتغير المزاج الشعبي، وعودة السيادة الوطنية كخطاب مركزي، لاسيما في الدول المنضوية ضمن كونفدرالية دول الساحل. ويبدو أن انسحاب هاتين القوتين لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل مثل إعلانا ضمنيا عن انتهاء مرحلة الهيمنة الغربية التقليدية في الإقليم، واعترافا بفشل المقاربات الأمنية التي طبقتها لعقدين من الزمن تحت عنوان مكافحة الإرهاب وبناء القدرات.
وقد أدى هذا الفراغ إلى بروز روسيا كلاعب صاعد في الإقليم، مستفيدة من الرغبة المحلية في التخلص من الإرث الاستعماري الفرنسي ومن هشاشة الترتيبات الأمنية القائمة، حيث اعتمدت موسكو على مقاربة غير متماثلة، توظف الشركات الأمنية الخاصة (على رأسها مجموعة فاغنر بنسخها المتحورة بعد مقتل مؤسسها)، مع ترويج خطاب سيادي موجه ضد الوجود الغربي. وتمكنت بفعل ذلك، من التمركز في بؤر القرار السياسي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، قبل أن تبدأ في تحويل هذا التمركز إلى تحالف مؤسسي ثلاثي، يحمل سمات تجمع دفاعي بديل عن "مجموعة دول الساحل الخمس".
ولم تأت هذه التحركات لتعبر فقط عن توسع نفوذ موسكو، بل لتدشن تحولات عميقة في تصور الفاعلين المحليين لشركائهم الدوليين، حيث باتت روسيا تقدم نفسها ويقدمها حلفاؤها الجدد كقوة غير استعمارية، أقل تدخلا في الشأن الداخلي، وأكثر استعدادا لتقديم الدعم المباشر دون شروط سياسية أو مؤسساتية. وتعد موريتانيا الدولة الوحيدة من دول الساحل التي ما تزال خارج المدار الروسي المباشر، وإن كانت عرضة مستقبليا لاستقطاب سياسي أو أمني ناعم، إذا استمرت حالة التراجع الغربي واستمر فشل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الوطنية في بلورة استراتيجية وقائية.
أما الصين، فتلعب دورا مغايرا قائما على استراتيجية الصمت الاستثماري طويل الأمد، حيث تنظر إلى منطقة الساحل بوصفها مجالا واعدا لتوسيع مبادرة الحزام والطريق، ولترسيخ مفهوم "الوجود الاقتصادي بدون تدخل أمني"، حيث تحرص بكين على تجنب التورط في الصراعات المسلحة أو الاصطفافات الإيديولوجية، وتركز بدلا من ذلك على المشاريع الهيكلية الكبرى، كتطوير البنى التحتية والنقل والطاقة، وعلى توقيع اتفاقيات استخراج المعادن وتوسيع الموانئ في الدول المستقرة نسبيا مثل موريتانيا والسنغال. ورغم تواضع حضورها العسكري أو الأمني، إلا أن الصين تضمن لنفسها موضعا متقدما في معادلات النفوذ الهادئ، وتعمل على بناء شراكات مرنة تمكنها من تعزيز تموقعها الاستراتيجي من دون إثارة حساسيات محلية أو اعتراضات دولية.
وفي خضم التنافس بين القوى الكبرى، تعاظم دور بعض القوى الإقليمية الساعية لإعادة تعريف نفوذها في ضوء الانسحابات الغربية، وتراجع القبضة الفرنسية التقليدية. فبينما تسعى الجزائر إلى فرض نفسها كضامن للأمن في الساحل من خلال مقاربات ثنائية تقوم على الوساطة وتقديم الدعم العسكري لبعض الدول والفواعل، يتحرك المغرب عبر شبكات متشعبة من العلاقات التجارية والدينية والدبلوماسية، ويقدم نفسه كفاعل إفريقي صاعد يملك نموذجا خاصا في الأمن الروحي والتنمية المندمجة.
أما تركيا، فتخوض معركة النفوذ من خلال توسيع اتفاقيات التعاون الدفاعي والتقني، مع اهتمام متزايد بفتح نوافذ في دول غير تقليدية في خارطتها الإفريقية، بينما تعمل دول مثل الإمارات وقطر على تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات الزراعة والطاقة والنقل، مستخدمة أدوات القوة الناعمة المالية بصيغ تتجنب التورط السياسي المباشر.
وهكذا فإن ما يميز المشهد الراهن في الساحل هو تداخل هذه الاستراتيجيات وتنافسها في ظل هشاشة الدولة وغياب المشروع الإقليمي الموحد، مما يجعل من المنطقة مسرحا مفتوحا لتجريب المقاربات المتناقضة، وحقلا معقدا لإعادة التموقع الدولي. وفي هذا السياق، تبرز موريتانيا بوصفها دولة "طرفية – مركزية" في آن، فهي ليست في قلب صراعات الساحل العسكري، لكنها واقعة على تخومه الجغرافية والاستراتيجية، مما يضعها أمام مسؤولية بناء استراتيجية وطنية متماسكة تحفظ لها الاستقلالية، وتحسن توظيف الفراغ الجيوسياسي القائم، وتجنبها التحول إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى كبرى تبحث عن موطئ قدم بأي ثمن.
وما تجدر الاشارة إليه، أن تعدد الاستراتيجيات الكبرى في منطقة الساحل لا يعكس فقط تشظي النظام الدولي واهتزاز أدوار القوى التقليدية، بل يكشف أيضا عن انتقال المنطقة من موقع التابع الجيوسياسي إلى موقع الفاعل المؤثر في تشكيل خرائط النفوذ العالمي. فبين انسحاب قوى الهيمنة القديمة، وصعود فاعلين جدد يعتمدون أدوات رمادية ـ تمزج بين الحضور غير المباشر، والتأثير الأمني والاقتصادي دون إعلان صريح ـ وأخرى متداخلة تجمع الاقتصاد بالسياسة، والثقافة بالاستثمار،تبرز الحاجة إلى قراءة متأنية لتحولات التموضع، وتفكيك رهانات الحضور المتناقض، واستيعاب أنماط التفاعل بين المحلي والخارجي. وتجد موريتانيا نفسها، في خضم هذه التحولات، أمام لحظة استراتيجية دقيقة، تفرض عليها مغادرة منطق الحياد السلبي، نحو تبني سياسة استباقية تضمن لها التموقع السيادي في معادلة تتشكل خارج إرادتها، لكنها لا يمكن أن تظل على هامشها دون ثمن استراتيجي باهظ.
المحور الثاني: التموقع الحذر لموريتانيا
في ظل بيئة إقليمية متقلبة، ساد فيها انهيار بعض الدول، وتصاعدت فيها التدخلات الخارجية، اختارت موريتانيا استراتيجية قائمة على الحذر والانضباط، متموضعة خارج سياق الاستقطاب بين المحاور، دون أن تغيب عن دوائر الفعل الإقليمي. هذا التموضع الحذر لم يكن نتاج انكفاء، بل ترجمة لعقيدة دبلوماسية واقعية، تدرك محدودية أدوات القوة الصلبة، وتراهن على بناء شراكات مرنة، وحفظ هوامش المناورة في إقليم تحكمه موجات الفوضى أكثر مما تضبطه مؤسسات الاستقرار.
لقد برز هذا الحذر في تعاطي نواكشوط مع الأزمات الإقليمية الكبرى، مثل الحرب المالية والأزمة الليبية، والانقلابات المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث حافظت موريتانيا على مسافة واحدة من الأطراف، مجنبةً نفسها الوقوع في فخ التحيز، ومانحةً لنفسها دور الوسيط المستعد لإسداء خدماته حين تقتضي الحاجة. ويعزى نجاح هذا النهج من بين عوامل أخرى إلى نجاح السلطات المتعاقبة في بلورة موقف دبلوماسي هادئ على العموم ومتدرج، لا يثير الشكوك لكنه في نفس الوقت لا يغيب عن دوائر التأثير.
وقد ساعد على تنفيذ هذه السياسة جملة من الأدوات النوعية، في مقدمتها الدبلوماسية المرنة التي مكنت موريتانيا من التعامل مع طيف واسع من الشركاء المختلفين أيديولوجيا واستراتيجيا، دون أن تفرط في ثقة أي طرف. كما تميزت المقاربة الأمنية التي انتهجتها بالدمج بين الحزم الميداني والوعي التنموي، حيث ركزت الدولة على ضبط حدودها الجنوبية والشرقية، وفي الوقت ذاته عملت على العمل على معالجة جذور التهميش والتطرف في المناطق النائية كلما كان ذلك ممكنا، ما عزز من صورة الدولة كفاعل أمني يحظى بمستوى من المسؤولية.
إضافة إلى ذلك، فقد شكل الخطاب الديني المعتدل إحدى ركائز التأثير الناعم، حيث استفادت موريتانيا من عمقها الثقافي والديني، ومن مكانتها في الحقل الإسلامي الإفريقي، لبناء صورة إيجابية تخالف النموذج المتطرف السائد في بعض مناطق الساحل. كما أسهم تماسك الجبهة الداخلية النسبي وابتعاد الأطراف الفاعلة فيها عن الانجراف خلف إغراءات استجداء التدخل الخارجي واللجوء إلى الأدوات العنيفة من أجل الوصول إلى السلطة، في توفير قاعدة للاستقرار الداخلي مكنت من التعامل بفعالية مع التحديات التي أربكت عدة بلدان وأوقعت ببلدان أخرى.
ورغم أهمية هذا التموضع، فإن التحولات المتسارعة في المنطقة بدأت تظهر حدوده، ذلك أن الحذر، حين يتحول إلى سياسة دائمة غير مصحوبة برؤية هجومية محسوبة، يكون مرشحا لأن يفقد فاعليته، بل إنه قد يصبح معيقا لأي شكل من أشكال المبادرة. وفي هذا الوقت بالذات الذي تعاد فيه هندسة التوازنات في منطقة الساحل، من خلال انسحاب قوى دولية ودخول أخرى، وتبدل خرائط التحالفات، يصبح لزاما على نواكشوط أن لا تكتفي بموقع المراقب، بل أن تسعى إلى التأثير في مسار التفاعلات الجارية.
وتتجلى مخاطر هذا الجمود في احتمالات تآكل الحضور الإقليمي لموريتانيا كما بدأت ملامحه تتضح على عدة صعد، سواء من خلال تجاوزها في التنسيقات الأمنية أو الاقتصادية، أو من خلال تمدد قوى إقليمية منافسة إلى مجالات كانت تقليديا ضمن دائرة التأثير الموريتاني أو ينبغي أن تكون كذلك. كما أن بعض الشركاء الدوليينالأساسيين، بمن فيهم الولايات المتحدة وفرنسا، قد يصبحون مضطرين إلى إعادة تعريف أولوياتهم وشركائهم بناء على من يتحرك لا من يكتفي بالصمت الاستراتيجي.
وتكمن المفارقة هنا في أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من شروط فاعلية ـ كالموقع الجغرافي، التماسك الداخلي، والرصيد الدبلوماسي ـ قد تجد نفسها على المدى القريب في موقع رد الفعل بدل الفعل، إذا لم تبادر إلى الانتقال من التموضع الدفاعي إلى التموضع الاستراتيجي المبادر، في سياق إقليمي لا يعترف إلا بمن يملك الجرأة على استباق الأحداث، لا من يكتفي بمحاولة تفاديها.
المحور الثالث: نحو صناعة نفوذ موريتاني في الساحل
في سياق يتميز بإعادة تشكيل الموازين الجيوسياسية في منطقة الساحل، بات من الضروري لموريتانيا أن تعيد التفكير في موقعها، لا كمفعول به في معادلات القوة، بل كفاعل يملك من الأدوات والرؤية ما يخوله صناعة نفوذ استراتيجي حقيقي في محيطه الإقليمي، ذلك أن التحولات المتسارعة لم تعد تتيح ترف الانتظار، ومن لا يسهم اليوم في هندسة التوازنات الناشئة، قد يجد نفسه على هامشها في القريب العاجل، مهما كانت شرعيته الجغرافية أو رمزيته التاريخية.
والواقع أن موريتانيا تمتلك عددا من مقومات التأثير التي يمكن توظيفها لبناء نفوذ متدرج وواقعي في الساحل. أول هذه المقومات هو موقعها الجغرافي، الذي يمنحها خاصية نادرة: كونها دولة عبور بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وبين الأطلسي وعمق الساحل. وهذا الموقع لا ينبغي أن يفهم فقط كجسر بين المنطقتين، بل كمنصة استراتيجية يمكن عبرها مراقبة التحركات العسكرية، والهجرة غير النظامية، والتجارة الإقليمية، وهو ما يجعل من موريتانيا فاعلا لا غنى عنه في أي مقاربة أمنية أو اقتصادية لمنطقة الساحل الغربي.
إلى جانب الجغرافيا، تتوفر موريتانيا على رصيد من الاستقرار المؤسسي والسياسي، تفتقر إليه بعض دول جوارها، فقد نجحت إلى حد ما حتى الآن في تحييد الخلافات الأيديولوجية والعرقية من المشهد الأمني، وراكمت خبرة في مكافحة التطرف العنيف بأسلوب متمايز، جمع بين الردع والمراجعة، وبين الأمن والتنمية. كما أن حيادها السياسي في الأزمات الإقليمية يمنحها مصداقية خاصة تؤهلها للعب أدوار الوساطة، التي يبحث عنها شركاء دوليون في لحظات التعقيد.
لكن صناعة النفوذ لا تتوقف عند توفر المقومات، بل تتطلب رؤية استراتيجية واضحة، تحدد مجالات التأثير المستهدفة، وتربط بين الأدوات المتاحة والأهداف الممكنة. وفي هذا السياق، يمكن لموريتانيا أن تتحرك ضمن ثلاثة مسارات متكاملة:
أولا، في المسار الأمني، لا يكفي أن تكتفي موريتانيا بدور المتلقي للدعم، بل يمكنها أن تقدم نفسها كطرف صاعد في معادلة أمن الساحل، من خلال تطوير مدرسة إقليمية متخصصة في التدريب على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تستقبل الضباط والمتدربين من دول الجوار، مما يعزز مكانتها كمرجعية أمنية مستقلة. كما يمكنها أن تطرح مبادرات لتنسيق أمني أفقي بين دول الساحل، بعيدا عن الوصاية الخارجية، مستفيدة من تجربتها الأمنية المتمايزة ومن علاقتها المتوازنة بالقوى الكبرى.
ثانيا، في المسار الدبلوماسي، تستطيع موريتانيا أن تتحول إلى منصة للحوار الإقليمي، عبر تنظيم منتديات دورية غير رسمية تجمع الفرقاء السياسيين والأمنيين من دول الساحل، لتبادل الرؤى وصياغة مقاربات مشتركة. كما يمكنها أن تستثمر في دبلوماسية المسارات الثانيةمن خلال إشراك خبرائها ومراكز بحثها في جهود الوساطة وبناء الثقة، بحيث تصبح نواكشوط وجهة للحوار لا فقط بوابة عبور جغرافي. ومن المهم في هذا المسار أن تبادر موريتانيا إلى اقتراح إطار جديد لتعاون دول الساحل، يكون مرنا وشاملا وغير مرتهن للتمويل الخارجي.
ثالثا، في المسار الاقتصادي والتنموي، ينبغي لموريتانيا أن تتبنى رؤية طموحة تجعل منها قطبا لوجستيا إقليميا في الساحل، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير شبكة نقل حديثة ومتكاملة تربط موانئ نواكشوط ونواذيبو وانجاغو بعمق الساحل، بما في ذلك مالي والنيجر وتشاد، مع إرساء منظومة عبور متعددة الوسائط (طرق، سكك حديدية، نقل بحري ونهري) تمكنها من لعب دور صلة الوصل بين المحيط الأطلسي والمناطق الداخلية.
كما يمكن لموريتانيا أن تعمل على استحداث مناطق حرة متخصصة، تقدم خدمات عبور وتخزين وإعادة تصدير، مما يجعلها نقطة ارتكاز في سلاسل الإمداد الإقليمية. وضمن هذا السياق، يمكن إنشاء "مركز الساحل لتأمين سلاسل الإمداد"، كمؤسسة إقليمية تعنى بضمان تدفق السلع والخدمات في ظل الأزمات والنزاعات، وتساهم في بناء قدرات لوجستية وتخزينية موجهة لدول الساحل الحبيسة. ولا يعزز هذا التموقع الاقتصادي النفوذ الموريتاني فقط، بل يمنح البلاد قدرة تأثير عملية على قرارات التنمية الإقليمية، ويفتح أمامها فرصا لشراكات دولية مبنية على المصالح المشتركة، وليس فقط على المساعدات العابرة.
ولضمان فعالية هذه المسارات، لا بد من تبني خطاب سياسي جديد، أكثر طموحا ووضوحا، يعيد تعريف الدور الموريتاني في الإقليم بلغة استراتيجية لا تخشى الطموح، ولا تستبطن التواضع المفرط، حيث يجب أن يكون هذا الخطاب قادرا على مخاطبة الداخل والخارج معا، وأن يقدم موريتانيا كدولة مبادرة وصاحبة مشروع، لا كفاعل يتكيف مع معطيات الآخرين.
ويتعين أن يرفد هذا الخطاب بأذرع فكرية وإعلامية تواكبه وتدعمه، من خلال تمكين مراكز البحوث الوطنية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية العمومية، والاستثمار في الإعلام الخارجي متعدد اللغات، وتوسيع الحضور الموريتاني في المنصات والمنتديات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ذلك أن صناعة الصورة والرمزية ليست أمرا ثانويا في هندسة النفوذ، بل أحد أعمدته الجوهرية، خصوصا في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة الناعمة والتأثير الرمزي.
وعليها خلال قيامها بهذه المجموعات، أن تدرك أن صناعة النفوذ ليست ترفا سياسيا، بل أصبحت ضرورة وجودية في منطقة تتشكل بسرعة مذهلة، وتعيد فيها القوى الفاعلة تحديد منطق الهيمنة والتموضع؛ كما أنه على حكامها أن يكونوا على قناعة تامة بأن بلادهم، بما تمتلكه من مقومات ومصداقية وحياد إيجابي، مرشحة للعب دور مركزي في إعادة هندسة المجال الساحلي، شريطة أن تنتقل من سياسة الانتظار والتكيف، إلى سياسة التأثير والمبادرة.
السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدور الموريتاني في الساحل
تتوزع الخيارات المستقبلية لموريتانيا بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أول يتمثل في التحول الاستراتيجي المحسوب، حيث تنجح الدولة في تفعيل التوصيات المقترحة من خلال سياسة خارجية نشطة، ومبادرات وساطة جريئة، وشراكات مدروسة، واستثمار حقيقي للمقومات الجغرافية والثقافية. هذا السيناريو يمكن أن يفضي إلى تموقع موريتانيا كوسيط موثوق، وشريك فاعل في المعادلات الإقليمية، مما يعزز من استقرارها ودورها ويمنحها موقعا تفاوضيا متميزا في خارطة التعاون المستقبلي.
أما المسار الثاني، فهو الاستمرار في التموضع الحذر، دون تطوير مقاربة استباقية. وهو سيناريو قد يحافظ على حد أدنى من الاستقرار، ويضمن تجنب الصدامات، لكنه يبقي موريتانيا على هامش التأثير، ويجعلها عرضة لتجاوزها من قبل قوى إقليمية أكثر دينامية، أو إغفالها في ترتيبات التعاون المقبلة، خاصة مع إعادة تشكيل المنصات والتحالفات.
ويبقى المسار الثالث هو التهميش والانكماش الاستراتيجي، وهو سيناريو متشائم تتحول فيه موريتانيا إلى طرف غير مؤثر في بيئتها، نتيجة التقاعس أو الانشغال الداخلي أو غياب الرؤية. في هذا السياق، تخسر الدولة كثيرا من مكانتها، وتفقد أدوات التأثير، وتصبح أكثر هشاشة أمام التهديدات العابرة، وأقل قدرة على حماية مصالحها أو فرض شروطها.
وما يجدر التأكيد عليه في الختام، أن صناعة النفوذ لم تعد ترفا سياسيا أو شأنا نخبويا يمارس في الهوامش، بل أصبحت ضرورة وجودية ملحة خصوصا في منطقة يعاد فيها تشكيل موازين القوة وتوزيع الأدوار بوتيرة متسارعة تفرض على الفاعلين أن يثبتوا حضورهم لا عبر الخطاب فقط، بل من خلال التأثير الفعلي وصناعة المعنى والموقع؛ فالقيمة الجيوسياسية اليوم لا تمنح على أساس الرمزية الجغرافية أو التاريخية وحدها، بل تنتزع عبر القدرة على المبادرة، وصياغة الوقائع، والتأثير في اتجاه التحولات بدل انتظار نتائجها.
وعلى صناع القرار في موريتانيا أن يدركوا أن بلادهم، بما تختزنه من مقومات مادية وبشرية، وبما راكمته من مصداقية نادرة وحياد إيجابي في فضاء مضطرب، تمتلك فرصة استراتيجية لصياغة تموضع متقدم ضمن معادلة الساحل الجديدة. غير أن هذه الفرصة لا تتحقق إلا عبر كسر نمطية التردد والانكفاء، والتحرر من عقلية الاكتفاء بالتموضع الوقائي، لصالح هندسة رؤية طموحة تؤمن بأن النفوذ لا ينتظر بل يبنى، وأن الدولة التي لا تبادر لا تؤخذ بعين الاعتبار، مهما كانت مكانتها الجغرافية أو التاريخية.
مركز أودغست للدراسات الإقليمية




.jpeg)








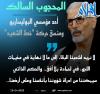




.jpeg)