
محمد المنى - نواكشوط
عكست المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الموريتانية، وأحاديث الناس داخل الصالونات والمكاتب والمقاهي، خلال العام الحالي الذي يودعنا (2021)، وجهاً محتقناً بالخوف والتوتر والتشاؤم لمدينة نواكشوط ولمزاج سكانها بعد ما عكّرته عدةُ أحداث تتابعت على المدينة خلال هذا العام. لقد تعرّض أمن السكان في العديد من أحياء العاصمة الموريتانية، لاسيما الأحياء الشعبية منها، لاعتداءات روّعت الكثيرين واضطرتهم لملازمة بيوتهم معظم الوقت. ولعل الجديد والمفاجئ في هذه الاعتداءات التي أذعرت الجميع، أن معظم مرتكبيها أحداث قصُّر، أي من صغار السن الذين مارسوا العنف واحترفوا جرائم السرقة والنشل والسطو والاغتصاب والقتل. وبالتدقيق في خلفياتهم يتضح أنهم جميعاً لم يستطيعوا الاستمرار في المدرسة أو لم يلتحقوا بها أصلا.
كما لم تكن سارّةً لسكان نواكشوط نتائجُ الامتحانات الوطنية السنوية الثلاثة لهذا العام، وهي امتحان مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية (كونكور)، وامتحان شهادة إتمام المرحلة الإعدادية (البريفيه)، وامتحان شهادة الباكلوريا (الثانوية العامة). لقد كشفت نتائج هذه الامتحانات ضعف النظام التعليمي الموريتاني، إذ أن نصف المترشحين لدخول الإعدادية أخفقوا في ذلك، أما الناجحون في الحصول على شهادة الدروس الإعدادية فكانوا أقل من خُمس المترشحين، فيما لم تتجاوز نسبة الناجحين في الدورة الأولى لامتحان شهادة الباكلوريا 8٪ من إجمالي عدد المترشحين. وعلى خلفية الحزن الذي خلقته هذه النتائج لدى الشارع وداخل آلاف البيوت، برز مجدداً السؤال: ما مصير كل هؤلاء الراسبين في الامتحانات الثلاثة؟ وكيف لا تكون هذه النتائج سبباً لتسربهم من المدرسة وانقطاعهم عن الدراسة؟ وما المسارات البديلة لتمكينهم من بناء حياتهم مستقبلا؟ وماذا عن احتمالية تحوُّل بعضهم نحو عالم الجريمة أو حتى الانزلاق نحو الإرهاب المسلح المتطرف؟
نلقي الضوء في هذا الملف الصحفي على جرائم صغار السن في نواكشوط، ونحاول التثبت من العلاقة بين انحراف القُصَّر وبين فشلهم الدراسي، من خلال الكشف عن الخلفيات التعليمية لعشرات القصَّر المحتجزين في مركز الميناء (المخصص لإيوائهم) بسبب جرائم مختلفة. كما نتفحص النظامَ التعليميَّ نفسَه، بحثاً عن أوجه القصور ومكامن الضعف.. أي العوامل التي تجعل آلاف التلاميذ يغادرون مدارسهم سنوياً لينضم بعضهم إلى عالم الجريمة وصفوف المجرمين القُصر.
وخلال ذلك نسأل المختصين والخبراء في مجالات الأمن والقانون والتربية والاجتماع والإعلام.. لاستطلاع آرائهم حول أوضاع الطفولة في سن التمدرس، وحول النظام التعليمي كبيئة حاضنة لشريحة عمرية واسعة من المجتمع (6-18)، وكذلك حول المقاربة الموريتانية الرامية إلى احتواء هذه الشريحة، حفظاً لأمن المجتمع وسكينته واستقراره، واستثماراً في جيل يعد رهانَ المجتمع وصانعَ مستقبله لا صانعاً لإرباكه أو سبباً لترويعه!
جرائم الصغار تزداد
لا تتوفر إلى الآن أي إحصائيات أو دراسات علمية متخصصة حول جرائم الأحداث وصغار السن في نواكشوط، لكن الانطباع السائد لدى الإعلاميين والمحامين والباحثين الاجتماعيين ومسؤولي الأمن.. هو أن هذه الجرائم في تصاعد مطرد. وقد يعود ذلك في جانب منه إلى النمو الديموغرافي الكبير الذي عرفه نواكشوط، إذ انتقلت من مدينة لا يتجاوز عدد سكانها خمسين ألف نسمة في أواسط الستينيات إلى مدينة يقطنها قرابة نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 4.6 مليون نسمة. وفي مثل هذه الحالة فالمتوقع دائماً هو أن تنشأ عن أي توسع حضري أو نمو ديموغرافي غير مصحوب بخطط لتوفير الخدمات 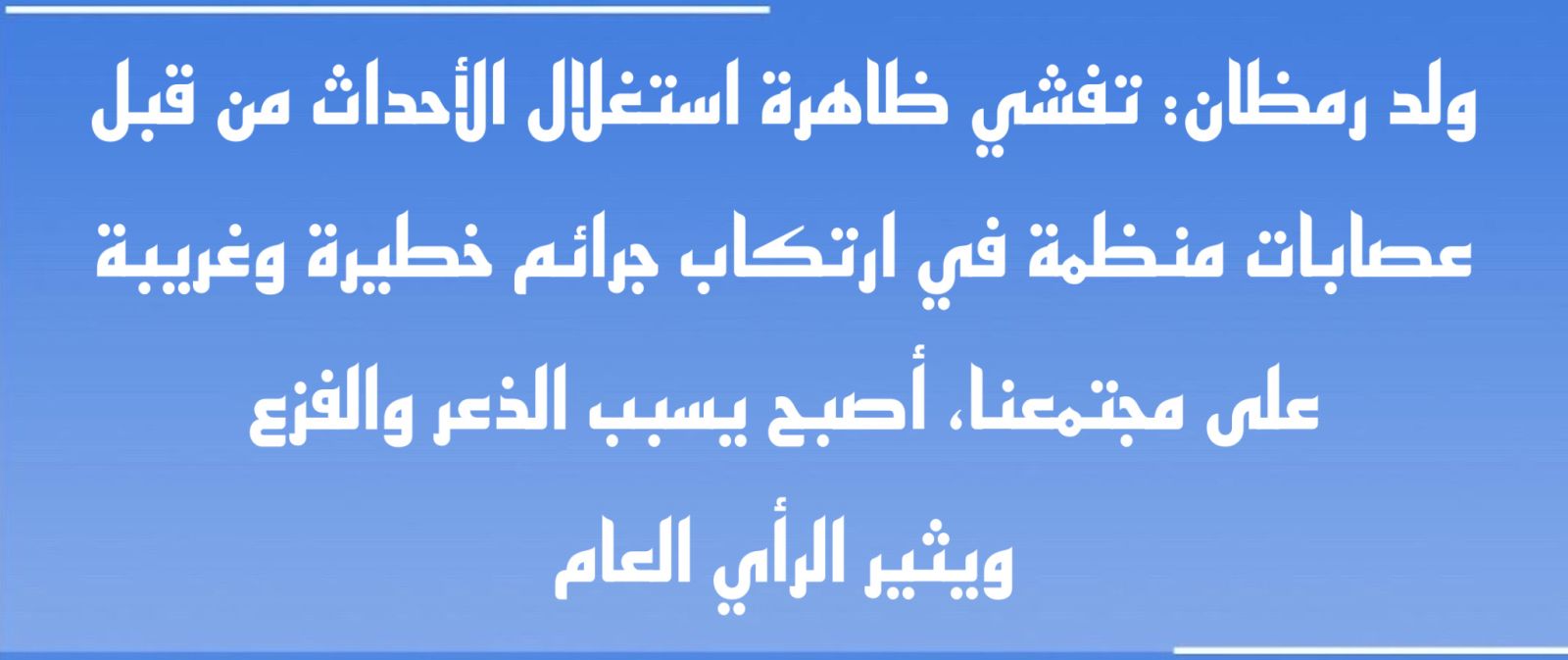 ومد البنى التحتية.. توتراتٌ واضطراباتٌ. وهذه من صميم الأعراض التقليدية المصاحبة عادةً لانتقال سكان الريف مِن مَواطنهم الأصلية إلى المدن وأحزمة الفقر من حولها، أي الظاهرة الشائعة جداً في عواصم الدول النامية على الخصوص.
ومد البنى التحتية.. توتراتٌ واضطراباتٌ. وهذه من صميم الأعراض التقليدية المصاحبة عادةً لانتقال سكان الريف مِن مَواطنهم الأصلية إلى المدن وأحزمة الفقر من حولها، أي الظاهرة الشائعة جداً في عواصم الدول النامية على الخصوص.
ويمكن القول إن ظاهرة جرائم الأحداث في نواكشوط قد زادت خلال الأعوام الماضية الأخيرة، وهو ما يؤكده المحامي ووزير العدل السابق حيمودة ولد رمظان الذي يرى أن المقلق في ظاهرة جرائم الأحداث هو تطورها الكمي، وكذلك قدرتُها على تجديد أساليبها، «خصوصاً بعد تفشي ظاهرة استغلال الأحداث من قبل عصابات منظمة لارتكاب جرائم خطيرة وغريبة على مجتمعنا، مما يسبب الذعر والفزع ويثير الرأي العام». كما يعتقد أستاذ علم الاجتماع الدكتور سيدي محمد ولد الجيد أن هذه الظاهرة «باتت تميل إلى التصاعد والكثافة والحدة». وهذا ما تجزم به أيضاً الباحثة الاجتماعية فايزة التاه، إذ تتحدث عن «موجة جرائم عرفتها العاصمة خلال عام 2021»، وتذكر أن «تحقيقات الشرطة تبين تفشي الجريمة في صفوف القصر»، وأنه «في العديد من حوادث السرقة والاغتصاب والقتل، يظهر وجودُ عنصر أو أكثر من مرتكبي الجريمة دون سن البلوغ.. مما يشير إلى تصاعد هذه الظاهرة بشكل مطرد».
وعلى النحو نفسه يعتقد كل الذين ناقشناهم وحاورناهم حول جرائم صغار السن في نواكشوط، أن هذا الصنف من الحوادث الإجرامية في تزايد مطرد، حتى وإن كانت وسائل الإعلام الجديد تبالغ في نقله أحياناً. وحول التأثير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي في النظرة إلى جرائم الأحداث، يقول الكاتب والناشط الثقافي والمجتمعي محمد الأمين ولد الفاظل، إنها لعبت دوراً مهماً في نقل أخبار الجرائم التي يرتكبها صغار السن، ولو أنها أحياناً كانت تنشر أخباراً كاذبةً، غير أن ذلك كان من بين أمور أخرى «دفعت بالشرطة الوطنية إلى أن تطلق صفحةً على الفيسبوك، وإلى أن تغذي هذه الصفحة بكل الأخبار المتعلقة بالجريمة». ويضيف ولد الفاظل أن هذه الصفحة «أصبحت تنشر اليوم، وبشكل فوري، أخبارَ الجرائم، وأصبح كل المهتمين بالموضوع يستقون الأخبارَ منها، الشيء الذي أوقف الإشاعات والأخبارَ الكاذبة التي كانت تملؤ مواقع التواصل الاجتماعي حول جرائم لم تقع أصلا، أو حول جرائم وقعت لكن تم تضخيمها بشكل كبير». 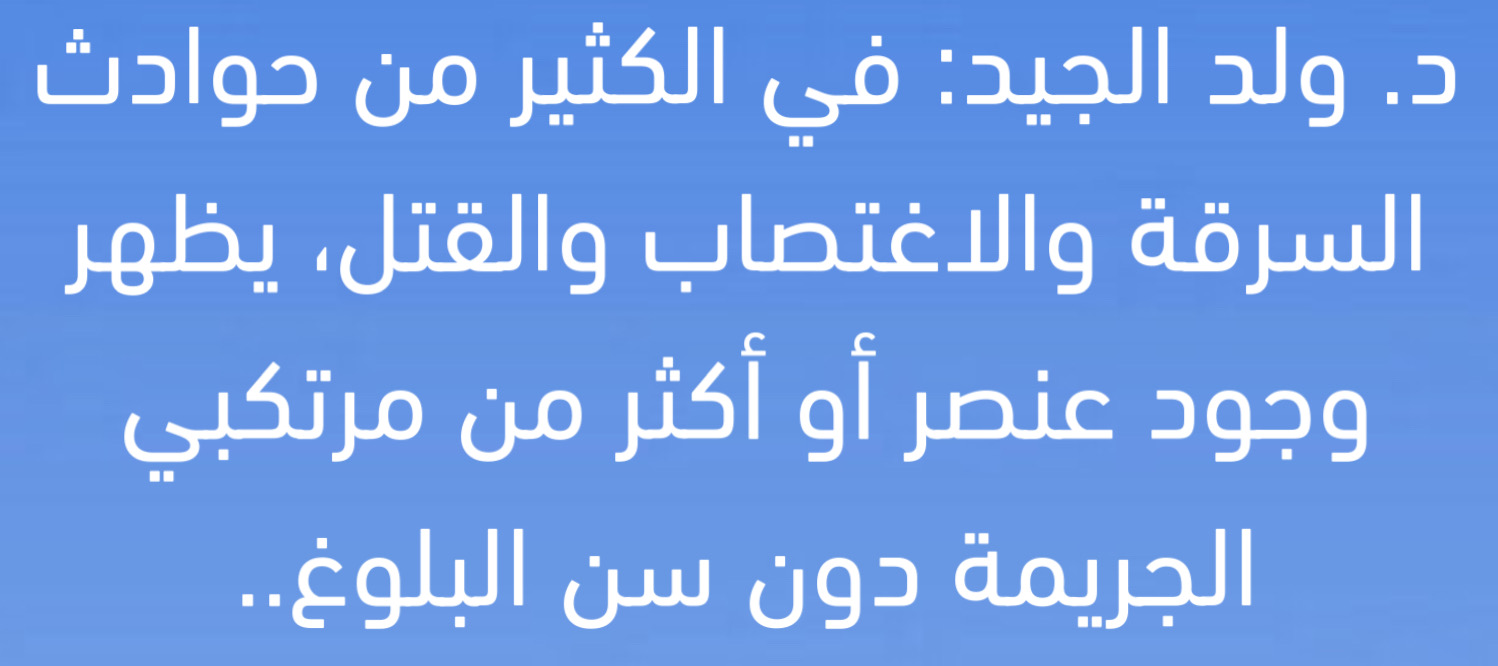
المقاربة القانونية
ومع ما يعتبره المتخصصون والمسؤولون الأمنيون تزايداً في أعداد الأحداث الجانحين منذ أعوام عديدة، جاء إنشاء هيئات قضائية مختصة بجرائم الأطفال، ومفوضيات شرطة معنية بهذه الجرائم أيضاً، بالإضافة إلى مركز لإيواء الجانحين القصر أو «المتنازعين مع القانون» (وهو المصطلح الرسمي). ويعود ذلك إلى عام 2003 عند ما قدّم صندوق الأمم المتحدة للطفولة دعماً للتكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون وضحايا العنف، حيث تم في العام التالي إنشاء غرف قضائية خاصة بالقصّر في محاكم الولايات، ثم تمت المصادقة في عام 2005 على الأمر القانوني المتضمن الحمايةَ الجنائيةَ للطفل. وفي عام 2007 جرى استحداث فِرق شُرَطية خاصة بالقصّر تحت سلطة وزارة الداخلية لتصبح هذه الفِرقُ حجرَ الزاوية في إصلاح قضاء الأحداث. كما صدر في عام 2009 المرسوم القانوني رقم 069/2009 المحدِّد للإجراءات البديلة لاحتجاز الأطفال الموجودين في وضعية نزاع مع القانون. ثم توسع الاهتمام بهذه الشريحة العمْرية من مرتكبي العنف وضحاياه مع المصادقة على المرسوم المتضمن إنشاءَ محاكمَ جنائية خاصة بالقُصَّر في عام 2010. 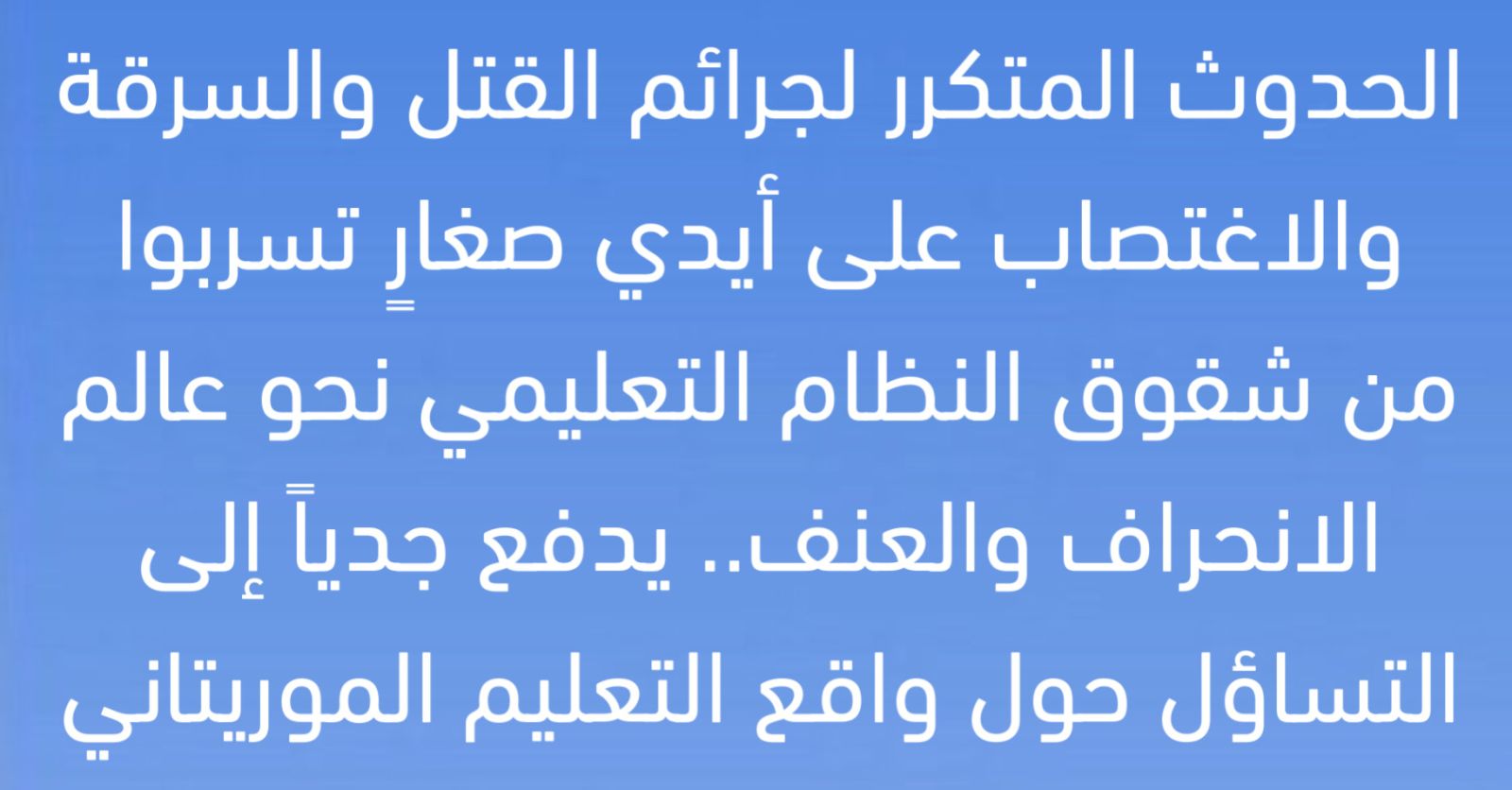 وفي العام التالي تسلَّمت وزارة العدل مركز إيواء القصَّر الجانحين الذي أصبحت تسميته الرسمية «مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون»، والواقع في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الغربية. وكانت منظمة «أرض الرجال» الإيطالية قد أنشأت المركز في عام 2008 وزوّدته بالمرافق والمنشآت الضرورية، بما في ذلك فصول دراسية وملاعب رياضية وورشات تدريبية.. ثم سلّمته في عام 2011 لوزارة العدل التي أصبحت مسؤولةً عنه، وأنشأت لهذا الغرض إدارة جديدة تدعى «إدارة إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون». ومنذ ذلك الوقت أصبح المركز يستقبل الأطفال المحالين من المحاكم على المستوى الوطني ككل.
وفي العام التالي تسلَّمت وزارة العدل مركز إيواء القصَّر الجانحين الذي أصبحت تسميته الرسمية «مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون»، والواقع في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الغربية. وكانت منظمة «أرض الرجال» الإيطالية قد أنشأت المركز في عام 2008 وزوّدته بالمرافق والمنشآت الضرورية، بما في ذلك فصول دراسية وملاعب رياضية وورشات تدريبية.. ثم سلّمته في عام 2011 لوزارة العدل التي أصبحت مسؤولةً عنه، وأنشأت لهذا الغرض إدارة جديدة تدعى «إدارة إعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون». ومنذ ذلك الوقت أصبح المركز يستقبل الأطفال المحالين من المحاكم على المستوى الوطني ككل.
صغار في المعتقل
ويتكون «مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون» من مركزين فرعيين متجاورين ويتبعان لنفس الإدارة، أحدهما «المركز المفتوح»، وهو يأوي أطفالا قابلين للتأهيل، أي الأطفال الأقل عنفاً، وهم من الفئة العمرية ( 12 -16 عاماً)، ويخضعون لعملية إعادة تأهيل ويتلقون تكويناً مهنياً ودروساً تعليمية منتظمة. أما المركز الفرعي الثاني فهو «المركز المغلق» الذي يأوي أطفالا أكبر سناً وأكثر عنفاً وأقل قابليةً لإعادة التأهيل، وهم يخضعون لحراسة مشددة على أيدي قواتٍ من «الحرس الوطني». ويتلقى نزلاء المركز المغلق دروساً تعليمية ودورات مهنية في مجالات النجارة والحدادة والسباكة. لكن ما أن يصل أحدهم سن البلوغ، حتى تتم إحالته بقرار من القاضي إلى أحد السجون المدنية لقضاء بقية محكوميته.
وحين زرنا المركز أثناء إعداد هذا الملف كان مجموع نزلائه 107 أطفال، منهم 29 في المركز المفتوح (بينهم 4 إناث)، و78 في المركز المغلق (كلهم من الذكور).
وبتصنيف نزلاء المركز المفتوح وفقاً لنوعية الجرائم المسجلة بحقهم، وجدنا 16 حالة سرقة، و5 حالات قتل، و4 حالات تعاطي مخدرات، و3 حالات سرقة مع كسر، وحالة اغتصاب وقتل واحدة.
أما المركز المغلق فيتوزع نزلاؤه بين الحالات التالية: 34 حالة سرقة ونشل، 10 حالات تكوين جمعية أشرار، 8 حالات حرابة، 6 حالات اغتصاب وقتل، 5 حالات قتل، 4 حالات استعمال مخدرات، 4 حالات اعتداء جسدي، وحالة هروب واحدة من المعتقل. 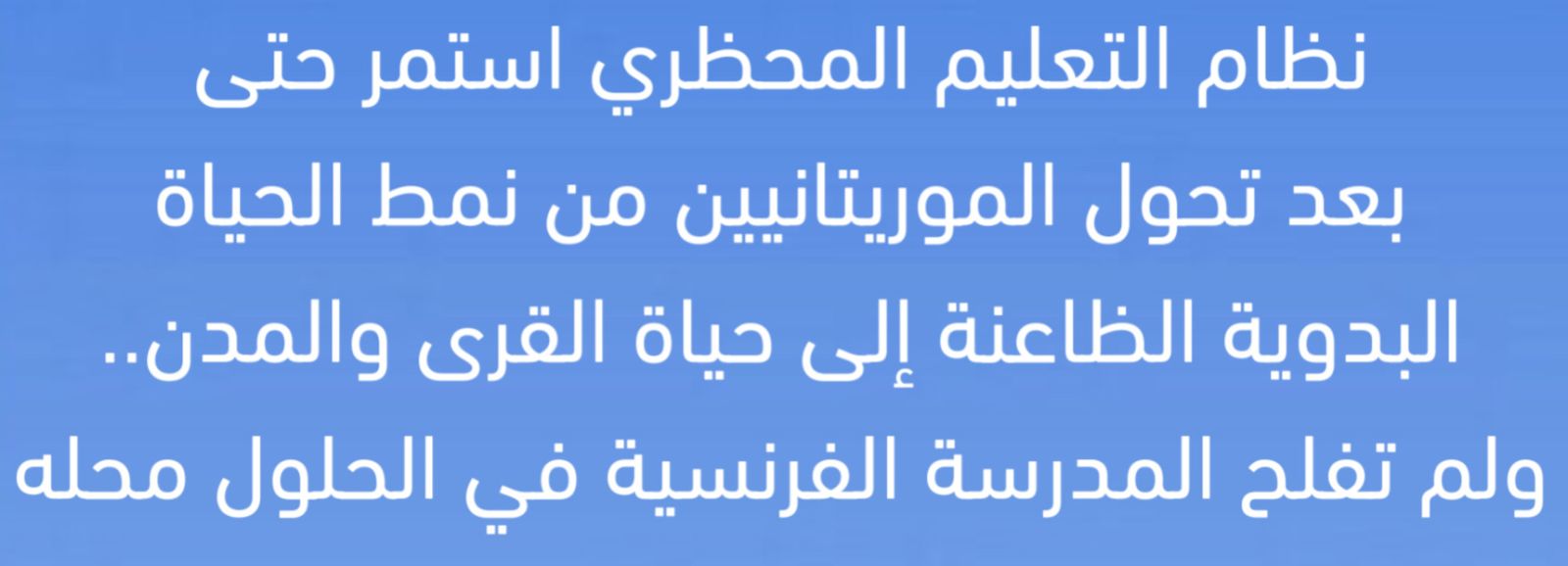
وفي ما يخص التوزيع الجغرافي لنزلاء المركز بفرعيه، فقد اتضح لنا أن 11 فقط من نزلائه محالون من محاكم في الولايات الداخلية للبلاد (بينهم حالة قتل واحدة)، بينما البقية محالون جميعاً من محاكم في نواكشوط بولاياته الثلاث، مما يشير إلى تركز هذا الصنف من الجرائم، أي جرائم صغار السن، في العاصمة أساساً.
وفي اليوم الأول لزيارتنا المركزَ، وبينما كنا نتحدث مع مديره، جاء شرطي مصطحباً خمسةَ أطفال كانوا يخضعون للاستجواب لدى المحكمة، وعادوا للتو كي يتم إيداعهم مجدداً في المركز محكم الإغلاق. وكان اثنان من الخمسة يحاكمان في قضية قتل، وثلاثة في قضية سطو وسرقة، وجميعاً كانوا قد اقترفوا الأفعال التي يحاكمون بشأنها داخل الحيز الجغرافي لمدنية نواكشوط.
وفي اليوم الثاني تصادف قدومنا مع موظفي المركز وهم يقومون بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد القصّر المحتجزين في المركز المفتوح على خلفية جريمة قتل، بعد أن استكمل فترة محكوميته (ثلاث سنوات)، وكان قد قَتَل ابن عمته (القاصر هو أيضاً) عقب تنزُاعِهما شريحة هاتف، حيث طعنه بسكين عدة طعنات مودياً بحياته، وذلك في بيت ذويه بأحد أحياء نواكشوط أيضاً.

قتل واغتصاب
وخلال جولاتنا بين المركز والمحاكم ومفوضيات الشرطة، تفحّصنا أواق اثنتين من أشهر الحوادث التي تجسد مثالا لجرائم القصّر خلال العام 2021 في نواكشوط، وقد أثارت كل منهما في حينها حالةً واسعة من الذعر والقلق بمختلف أرجاء المدينة. 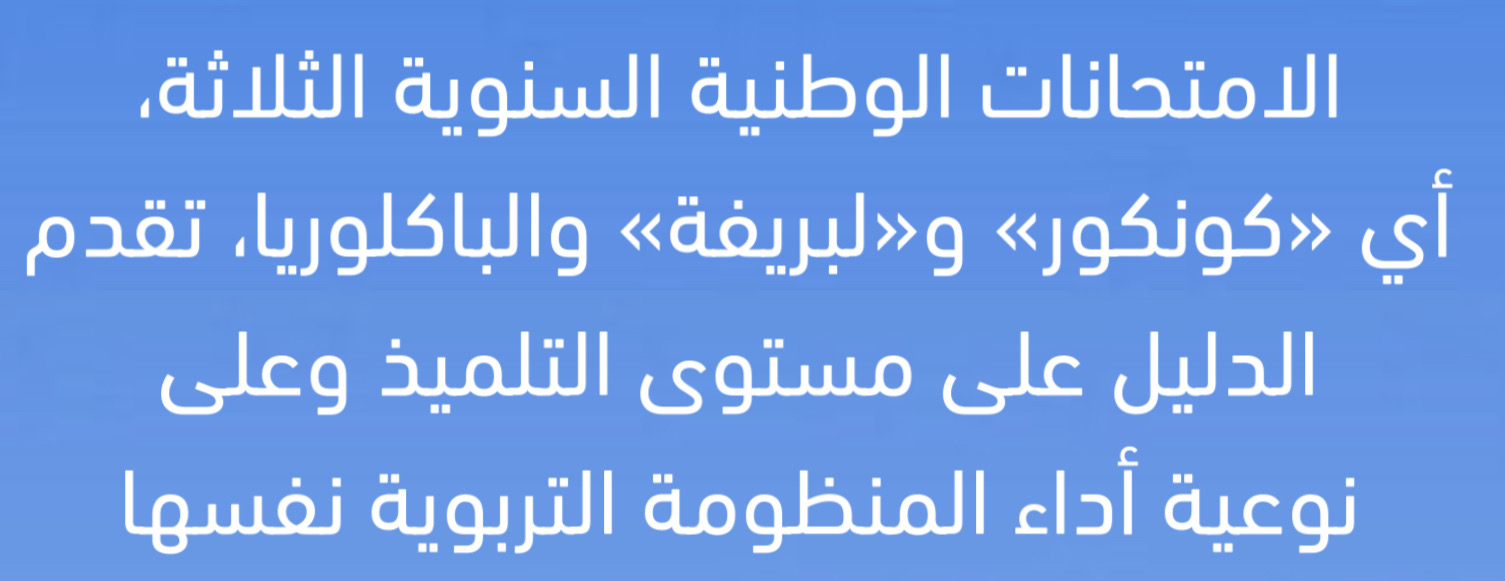
الحادثة الأولى هي مقتل الشاب (أ. و. ث) في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، وهي مثال لجرائم القتل التي يرتكبها شباب يستسهلون الشجار بدوافع عنفية كامنة أججتها المخدرات ولم تهذّبها المدرسة ولا الأسرة. وقد جرت هذه الحادثة زوال يوم الخامس من فبراير 2021، والضحية فيها هو (أ. و. ث) المولود عام 1997، أما المشتبه فيهم فهم: (ح. و . د. م) المولود عام 1997، و(ش. و. ح) المولود عام 2001، و(ب. و. م. أ) المولود عام 2005، و(ب. و. م. أ) المولود عام 2004، وأخيراً (س. و. د.) المولود هو أيضاً عام 2004.
وطبقاً لمحاضر التحقيق التي أجرتها الجهات الشُّرَطية والقضائية في نواكشوط الشمالية، فقد اعترف (ح. و. د. م) بمسؤوليته عن مقتل الضحية، وطابق سردُه للوقائع ما جاء في تصريح رفيقيه لحظة الواقعة، أي (ب. و. م. أ) و(ش. و. ح). وقد بدأت الوقائع عندما كان الثلاثة يحتسون الشاي تحت عريش اعتادوا استخدامه في حي الجزيرة الذي تقطنه أسرهم. وقد طلب (ب. و. م. أ) من (ح. و . د. م) أن يتصل له هاتفياً على أخيه (ب. و. م. أ)، ففوجئ (ح. و . د. م) بشخص آخر يرد عليه بشتائم وتهديدات ويتبجح بأنه هو من انتزع الهاتف من صاحبه، كما يتحدى أي شخص يستطيع استرجاع الهاتف منه. وتطور الأمر إلى أن تواعدا على «شارع التيو» للمواجهة هناك. وعلى الفور توجه (ح. و . د. م) إلى المكان المحدد للمواجهة، وبعد قليل وصل الطرف الآخر وهو (أ. و. ث)، لينشب عراك استطاع خلاله (ح. و . د. م) أن ينتزع سكيناً كان (أ. و. ث) يشهرها في وجهه، ثم بدأ يطعن بها جسمه من أماكن مختلفة، لينسحب من مسرح المعركة تاركاً (أ. و. ث) غارقاً في دمه. عاد (ح. و . د. م) إلى العريش ومعه كل من رفيقيه (ش. و. ح) و(ب. و. م. أ). وهناك قدِم عليهما (ب. و. م. أ) فأخبروه بأنهم استرجعوا له هاتفه من اللص أو السارق. وكما صرح (ب. و. م. أ) فإنه في صباح ذلك اليوم اعترض طريقه شخص مسلح بسكين، وكان يبدو واقعاً تحت تأثير المخدرات، فسلبه هاتفه بعد أن أشهر سكيناً في وجهه. وفي طريق عودته وقت الظهيرة شاهدَ (ب. و. م. أ) الشخصَ نفسَه جثةً مرميةً على «شارع التيو»، ثم واصل طريقه نحو العريش ليجد الشباب مجتمعين، وما أن ناولوه هاتفَه حتى عرف أنهم مَن قتلوا ذلك الشخص، وعلى الفور بادر بسؤالهم: مَن القاتل فيكم؟ فرد (ح. و . د. م) بأنه هو مَن تولى بنفسه قتل (أ. و. ث). 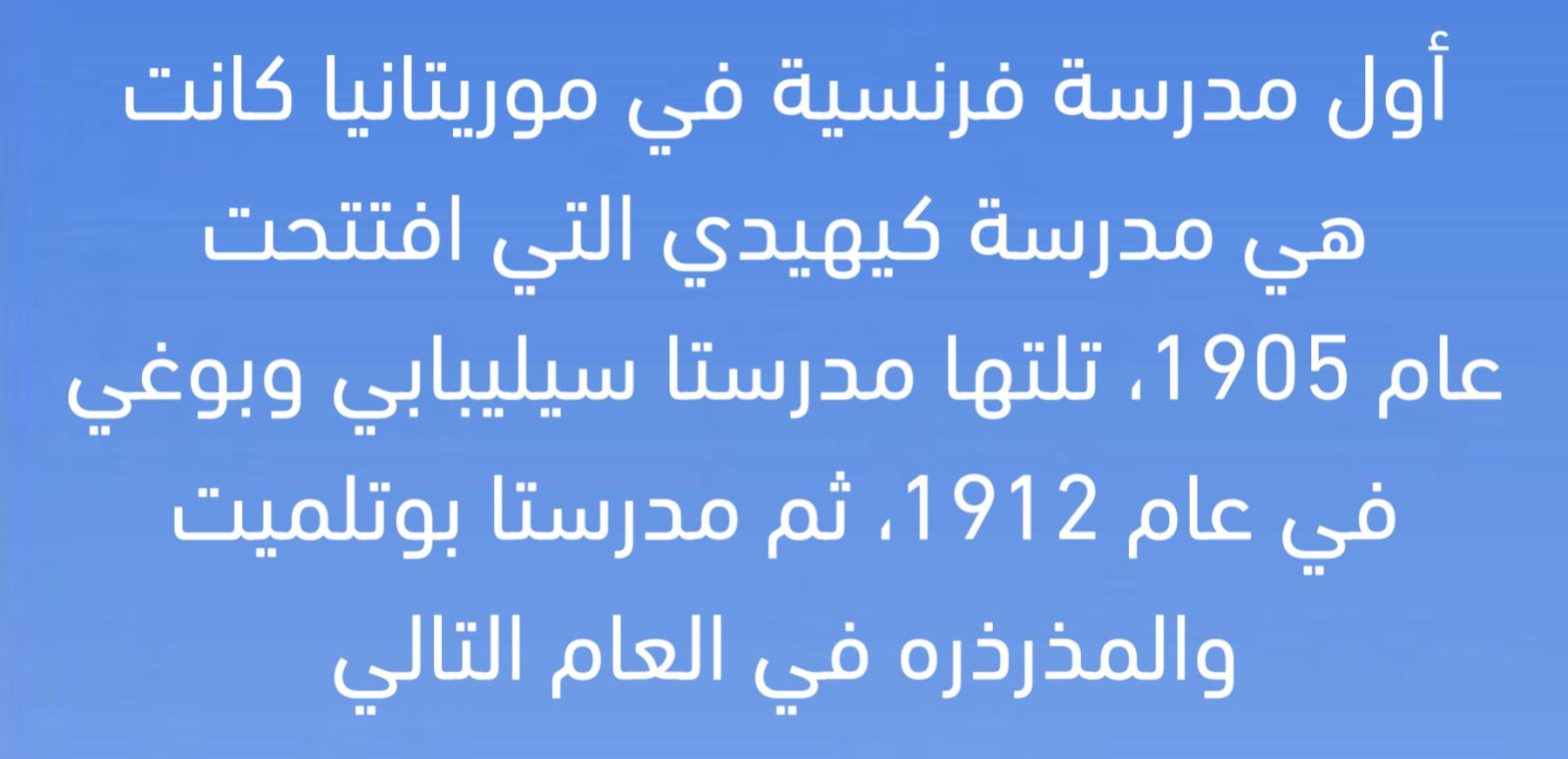
أما المثال الثاني لجرائم صغار السن التي روعت نواكشوط خلال الصيف الماضي، فهو حادثة اقتحام بيت (و. ب. أ) والاعتداء عليها وعلى أفراد أسرتها وسلبهم بعض متعلقاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وقد وقعت فجر يوم الـ17 من يونيو 2021 في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، حين قام ثلاثة مراهقين بكسر باب العريش الإسمنتي الذي كانت تنام فيه (و. ب. أ) وأطفالها الأربعة وأمها وشقيقتها الكبرى، مطالبين الجميع بالتزام الصمت وبتقديم كل ما لديهم من نقود ومجوهرات وهواتف وبطاقات تزويد بالرصيد وأي أشياء أخرى ذات قيمة. وقد امتثلت الأم وابنتاها للأوامر وقدَّمن كلَّ ما بحوزتهن للمهاجمين. لكن هؤلاء طلبوا من (و. ب. أ) مرافقتَهم إلى غرفتها المجاورة للعريش، لكي تكشف لهم عما إن كانت هناك نقود أو حلي. وفي الغرفة قام اثنان من اللصوص بالتعاقب على اغتصابها حتى فقدت الوعي، بينما كان شريكهما الثالث يقوم بالحراسة في الخارج. وبعد أن أكملوا المهمة آخذين معهم النقود وبطاقات تزويد الهاتف، انسحبوا تاركين وراءهم نساءً وأطفالا مروَّعين جميعاً وامرأة أصبحت على حافة الجنون بعد أن فعلوا بها ما فعلوا. وفور تَبلّغ الشرطة بخبر الحادثة بدأت التحقيق والتحري عن المنفذين، لتقوم في اليوم نفسه بإلقاء القبض على أحدهم وهو (أ. و. ح). ومن خلال هاتفه تعرفوا على (ع. و. ز) الذي كان شريكاً له، فقاموا باستدراجه عن طريق (أ. و. ح) الذي حدد له موعداً للقاء عند وقفة توجنين، وهناك استطاعت الشرطة الإمساك به. وقبل أن يغادروا المكان، اتصل الشريك الثالث في الجريمة، وهو (ب. و. م. أ)، ليخبر (ع. و. ز) بأنه في مقاطعة الرياض، وبطلب من الشرطة أخبر (ع. و. ز) صديقَه (ب. و. م. أ) بأنه قادم إليه هناك. وفي المكان المحدد بالرياض كان (ب. و. م. أ) على الموعد، لكنه تفاجأ بكمين الشرطة فحاول مقاومتهم مستلا من داخل ثيابه سكيناً، إلا أنهم ألقوا عليه القبض في النهاية.
ولعل المفاجئ حقاً في هاتين الحادثتين هو أن (ب. و. م. أ) الذي كان ضحية لـ(أ. و. ث) عندما سلبه هاتِفَه تحت التهديد بالسلاح الأبيض، هو نفسه بطل جريمة اغتصاب (و. ب. أ) تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي حدثت بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط.. مما يثير أحدَ الأسئلة الأثيرة في تاريخ الفكر الإنساني: كيف يتحول الضحية البريء إلى قاتل مجرم؟
وبالاستطلاع عن الخلفية الدراسية والسجل السلوكي لـ(ب. و. م. أ) وجدنا أنه تابع بصعوبة في المدرسة الحكومية بحيه (الجزيرة)، وأنه تركها في الصف الخامس، ليبدأ تأدية بعض الأعمال اليدوية، مثل نقل القمامة من أمام المنازل مقابل مبلغ مالي صغير، لكنه سرعان ما أصبح شريكاً في عصابة من أترابه تمارس النشل وتتعاطى المخدرات، وجميع أفرادها ممن تمدرسوا في البداية، لكن المدرسة عجزت عن الاحتفاظ بهم إلى أن يصلوا المرحلةَ الإعدادية. كما اتضح لنا أن (أ. و. ث) الذي كان يمارس النشل والسرقة والسطو، وكثيراً ما هدد المارة بالسلاح الأبيض وهو تحت تأثير المخدر، هو كذلك أحد ضحايا التسرب المدرسي، إذ انقطع عن دراسته في المرحلة الإعدادية لينخرط في عالم الجريمة والعنف والمخدرات.
ويدفع الحدوث المتكرر لمثل هذه الجرائم على أيدي صغارٍ تسربوا من شقوق النظام التعليمي نحو عالم الانحراف والعنف، إلى التساؤل بجدية: ما هو واقع التعليم في موريتانيا؟ وما مشكلاته ومعوقاته وأوجه قصوره؟ ومن أي مصدر تنبع الأسباب التي تدفع سنوياً بعشرات الآلاف من الأطفال إلى مغادرة المدرسة نحو الشارع لتتلقف بعضَهم عصاباتُ الجريمة والمخدرات؟
من المحظرة إلى المدرسة
سعت فرنسا على مدى ستة عقود من وجودها المباشر في موريتانيا إلى إدخال تحديثات عميقة على بنية المجتمع، لاسيما نسقه الثقافي ونظامَه التعليمي. لكن كان قد سبق للموريتانيين (الشناقطة) أن طوروا نظاماً تعليمياً يلائم نمط حياتهم البدوية المتنقلة، يُعرف باسم بالمحظرة، وقد أصبح جزءاً من نسق حياتهم على مدى قرون عديدة قبل دخول الفرنسيين إلى البلاد عام 1903، وهو نظام يتمثل محتواه في المتون اللغوية والأدبية العربية من العصرين الجاهلي والإسلامي، وفي نصوص الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية. أما منهجه فيقوم على نظام التعليم الفردي، حيث يختار الطالب ما يناسبه من تلك النصوص والمدونات. أما المحظرة كبنية تنظيمية فتتمحور حول شيخ متمكن من العلوم اللغوية والشرعية، يلتحق به الطلاب في مخيمه ويرافقونه خلال الترحال الانتجاعي للمخيم. 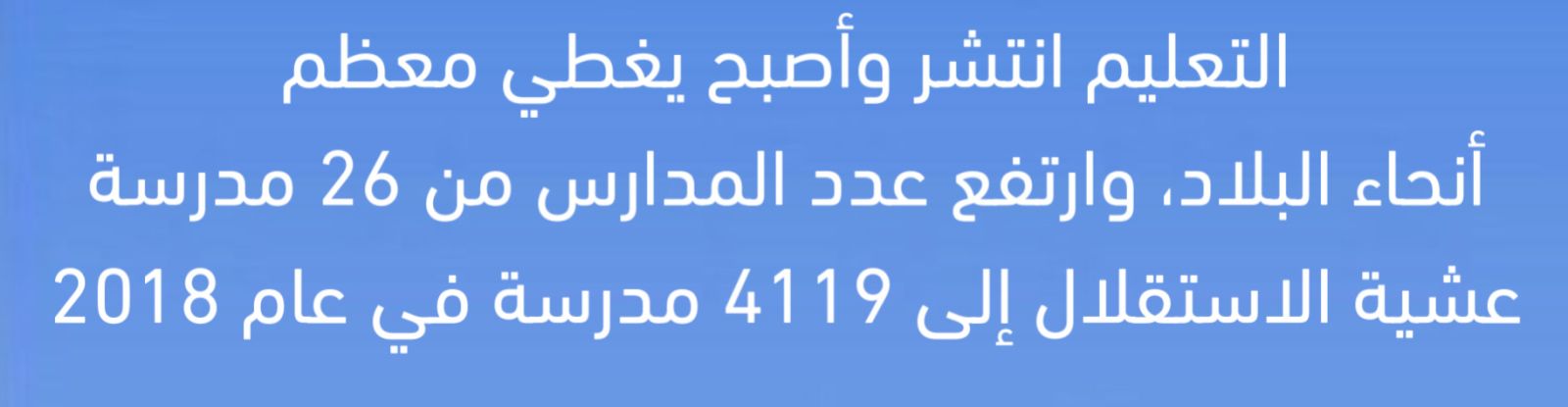
وقد استمر هذا النظام، وإن بشكل آخر، حتى بعد تحول الموريتانيين من نمط الحياة البدوية الظاعنة إلى حياة القرى والمدن، ولم تفلح المدرسة الفرنسية في الحلول محله. وكانت أول مدرسة فرنسية في موريتانيا هي مدرسة كيهيدي التي افتتحت عام 1905، تلتها مدرستا سيليبابي وبوغي في عام 1912. وفي العام التالي رأت النورَ مدرستا بوتلميت والمذرذره، ثم تلتهما مدرسة تنبدغة عام 1933، فمدرسة أطار عام 1936، لتفتتح بعدها مدرسة كيفه عام 1939. وبحلول عام 1941 أصبح عدد المدارس على عموم التراب الموريتاني أربع عشرة مدرسة تضم 900 تلميذاً.
ويتحدّث «فرانسيس دي شاسيه» عن النتائج الهزيلة المحرَزة في هذا المجال خلال ستة عقود من الاستعمار، ويذكر أن التلاميذ الموريتانيين الحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية بحلول عام 1931 لم يتجاوز عددهم العشرة. كما يتطرق إلى نسبة التمدرس في ذلك العام قائلا إنها بلغت في أعلى تقديراتها 1.1 في المئة، ثم أصبحت 1.6 في المئة عام 1948.. وهو التطور الذي استمر بوتيرته البطيئة حتى عشية نيل البلاد استقلالَها عام 1960.
ويذكر المختار ولد داداه، أول رئيس لموريتانيا بعد استقلالها، أن البلاد في مطلع الستينيات كانت تعاني تأخراً كبيراً في مجال التعليم والتمدرس والتكوين. ويقول في مذكراته، «موريتانيا على درب التحديات»، إن «عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية لم يكن يزيد على نحو خمسة آلاف تلميذ، ونحو أربعمائة تلميذ موزعين بين المؤسسة الثانوية الوحيدة في البلاد (إعدادية روصو) والثانويات السنغالية، وقرابة العشرين من الطلبة الجامعيين موزعين بين داكار وفرنسا».
لكن النظام التعليمي الموريتاني عرف تطوراً كمياً كبيراً خلال العقود الستة اللاحقة، كما عرف عدة إصلاحات كان لها أثرها في التحولات الكمية والنوعية لهذا النظام. وقد جاء أول هذه الإصلاحات في ظل حكومة الاستقلال الداخلي عام 1959، وكان هدفه إدخال اللغة العربية والتربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية. ثم صدر في عام 1965 قانون يقضي بإلزامية تدريس اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية في التعليم الثانوي. وفي عام 1967 جاء ثاني إصلاح تعليمي موريتاني، وقد أريد به هو أيضاً تحسين وضعية اللغة العربية. ثم جاء إصلاح عام 1973 الذي أقر نظامين للتعليم الثانوي: نظام عربي تُدرَّس فيه كافة المواد باللغة العربية (والفرنسية فيه لغة أجنبية أولى)، ونظام مزدوج تُدرَّس فيه المواد باللغة الفرنسية، مع تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وتضمن هذا الإصلاح إنشاء باكلوريا وطنية لأول مرة، كما استحدث «المعهد التربوي الوطني» و«المدرسة العليا للتعليم»، ليشرع المعهد في توفير البرامج والكتب المدرسية، ولتبدأ المدرسة العليا في إعداد وتكوين الأساتذة الموريتانيين. أما إصلاح عام 1979 فتضمن فصل التعليم إلى تعليمين؛ تعليم عربي إجباري لأبناء العنصر العربي، وتعليم فرنسي متاح لأبناء العنصر الأفريقي. وأخيراً كان إصلاح عام 1999 الذي أعاد توحيد النظام التربوي، لكن مع العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية. وهو النظام القائم حالياً، والذي يحمّله البعض (من الأهالي والخبراء) المسؤوليةَ عن واقع التعليم ومستويات طلابه ونوعية مخرجاته.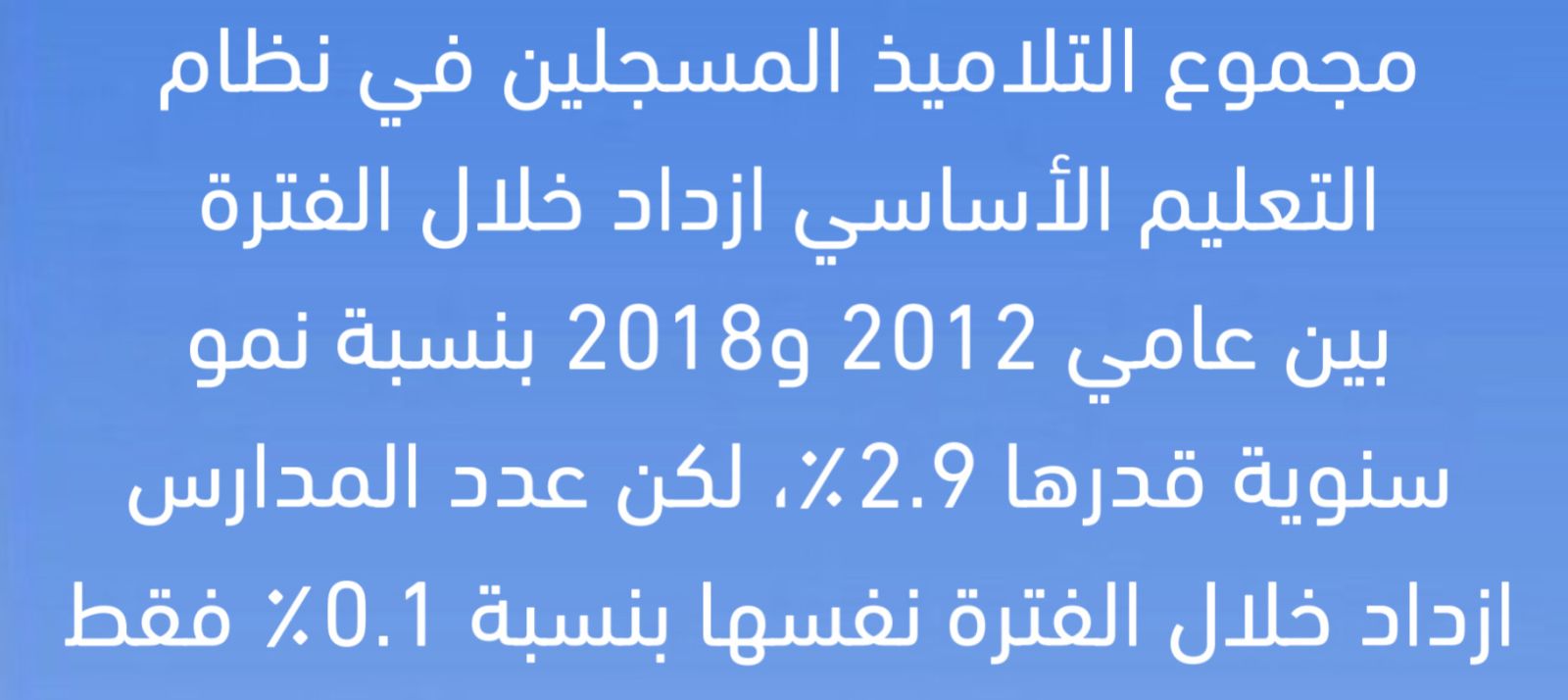
البنية التحتية للتعليم
بذلت الدولة الموريتانية جهوداً كبيرةً للنهوض بالتعليم ولتوسيع انتشاره وتطوير بنيته التحتية وتجويد أدائه وتحسين مخرجاته، وخصصت نسبة إنفاق على التعليم بلغت في السنوات الأولى للاستقلال نحو 33٪ من الميزانية العامة للدولة، وظلت تدفع إعانات ومنحاً دراسية لتلاميذ المدارس الابتدائية في الداخل وتخصص سكناً داخلياً في كل المدارس الإعدادية والثانوية. وبهذه الجهود والسياسات والإصلاحات، انتشر التعليم وتوسعت بنيته التحتية وأصبحت تغطي جميع أنحاء البلاد تقريباً، وارتفع عدد المدارس من حوالي 26 مدرسةً عشية الاستقلال عام 1960 إلى 4119 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في عام 2018، تحتوي على نحو 11029 حجرة دراسية. كما انتقل عدد المدارس الإعدادية والثانوية من إعدادية واحدة في روصو عام 1960 إلى 418 مدرسة إعدادية وثانوية في جميع أنحاء البلاد عام 2018. لكن هل كان هذا التوسع كافياً لاستيعاب الزيادات المتواصلة في عدد التلاميذ؟
لقد عرفت موريتانيا نمواً ديموغرافياً ملحوظاً خلال العقود الستة الأخيرة من تاريخها، إذ ارتفع عدد السكان من 845 ألف نسمة في عام 1960 إلى 4.6 مليون نسمة في عام 2019، كما ارتفع عدد الذين يعيشون في القرى والمدن إلى نحو 90٪ من السكان حالياً بدلا من 5٪ عام 1960، وذلك لأسباب على رأسها الجفاف الذي ضربت البلادَ موجاتُه المتتاليةُ منذ أواخر الستينيات وقوضت دعائمَ الاقتصاد الريفي وأجبرت السكان على مغادرة مَواطنهم الأصلية إلى المدن، لاسيما العاصمة نواكشوط التي تضاعف حجمها عدة مرات منذ ذلك الوقت. بيد أن هذا النمو الديموغرافي لم يصاحبه توسع مماثل في البنى التحتية والمرافق الخدمية، خاصةً على مستوى المنظومة التعليمية التي تمثل الأداة الضرورية لتحقيق الاندماج الوطني وللانخراط في رهانات التحديث والعصرنة ولتسهيل الحراك الاجتماعي الطبقي. 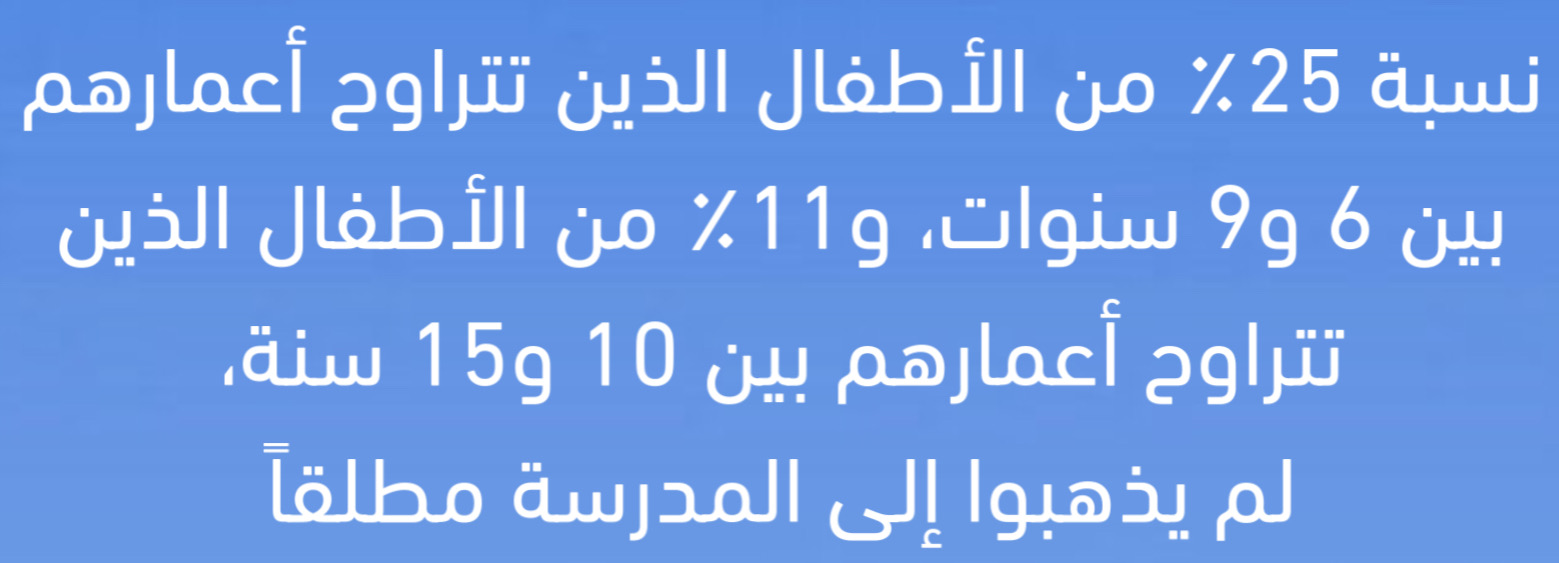
وبينما يبلغ معدل النمو السكاني في موريتانيا حوالي 2.35 في المئة سنوياً، فإن نمو حجم البنية المادية للنظام التعليمي لا يكاد يستجيب لتلك الزيادة الديموغرافية السنوية. ولذلك فقد بلغ مجموع عدد التلاميذ المسجلين بنظام التعليم الأساسي في عام 2012 نحو 552.6 ألف تلميذ، ليرتفع في عام 2018 إلى 655.3 ألف تلميذ، أي بزيادة سنوية قدرها 2.9 في المئة، لكن عدد المدارس ازداد خلال الفترة نفسها بنسبة 0.1 في المئة فقط، وذلك بارتفاعه من 4100 مدرسة إلى 4119 مدرسة. بينما انتقل عدد الفصول الدراسية، وخلال الفترة ذاتها أيضاً، من 11485 إلى 11029 فصلا، أي بتراجع نسبته 0.7 في المئة.
ويشير هذا التفاوت بين معدلات التغير إلى واحدة من معضلات التعليم الموريتاني، ألا وهي محدودية البُنى التحتية وعجزها عن الاستجابة للطاقة الاستيعابية المطلوبة، وهو ما تنشأ عنه مشكلة يتمثل أحد وجهيها في التكدس والاكتظاظ داخل الفصول، لاسيما في المدن الكبرى حيث يحدث أن يتجاوز عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد 100 تلميذ. أما الوجه الآخر لمشكلة البنى التحتية فيتمثل في «المدارس غير المكتملة»، إذ وفقاً لإحصاءات وزارة التهذيب الوطني الموريتانية، لعام 2018، فإن متوسط عدد الحجرات لا يزيد عن 2.7 حجرة لكل مدرسة. وبالإضافة إلى ذلك تتحدث الوزارة عن وجود 2586 مدرسة «في حالة غير مواتية»، وهو تقريباً ما أشار إليه تقرير البنك الدولي الصادر عام 2020، والذي جاء فيه أن 62% من مدارس موريتانيا «غير مكتملة». وعرّف البنك هذه الفئة من المدارس بالقول إنها تلك التي «ينقصها مستوى أو أكثر من مستويات المرحلة التعليمية المعنية». وأرجع البنك انتشار المدارس غير المكتملة في الأوساط الريفية إلى «رغبة السلطات العمومية في توفير تعليم للمواطنين»، وإلى «ضآلة الكثافة السكانية، وتشتّت التجمعات البشرية على رقعة جغرافية واسعة». وبالطبع فإن هذه المدارس غير المكتملة لا توفر فرصةَ استمرارية الدراسة للتلاميذ الذين يرتادونها، أي إمكانية الانتقال من صف إلى الصف الذي يليه، مما يزيد فرص التسرب المدرسي.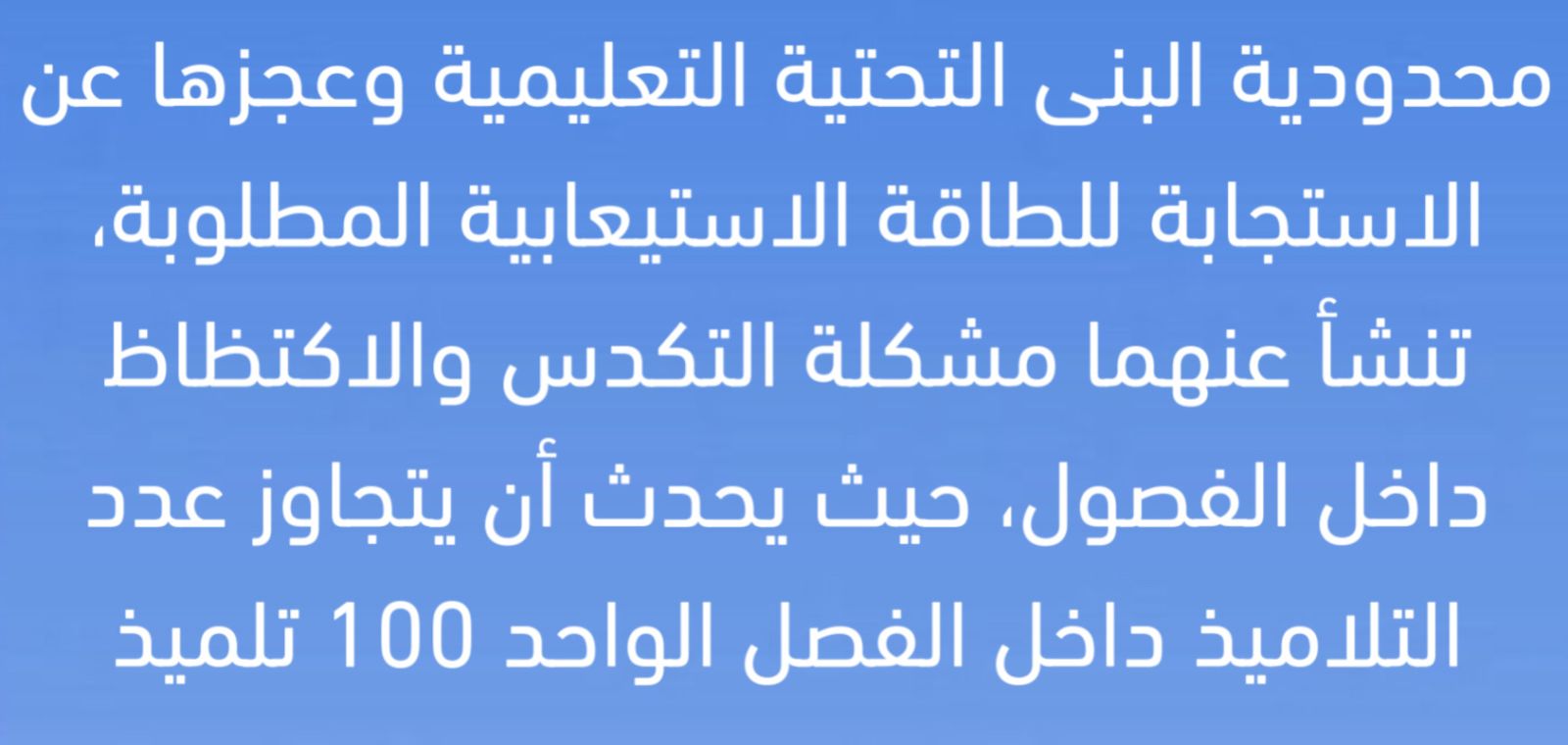
وفي ذلك التقرير الذي تطرّق إلى البنية التحتية للمدارس الابتدائية والثانوية في موريتانيا، أوضح البنك الدولي أن 96 في المئة من هذه المدارس لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط اللازمة للدراسة، بما في ذلك نقص المقاعد ودورات المياه والافتقار للكهرباء والماء وقاعات المعلوماتية وفضاءات الألعاب الرياضية. وقد حدد نقص المقاعد بـ145 ألف مقعد. أما المراحيض المتوفرة فلا تزيد عن مرحاض واحد لكل 32 صفاً. بينما تنعدم ساحات الألعاب الرياضية في 80 في المئة من هذه المدارس. كما ذكر التقرير أن ثلثي تلاميذ الصف الرابع ابتدائي في هذه المدارس لا يتوفرون على الحد الأدنى من الوسائل التعليمية، كما لا يتوفر نصفهم على سبورة صالحة للاستعمال داخل الصف. وأوضح التقرير أنه من أصل 308 إعداديات على التراب الوطني الموريتاني، تتوفر منها 121 فقط على الماء والكهرباء. ومن أصل 110 ثانويات، فإن 22 منها لا تتوفر على الماء و36 لا تتوفر على الكهرباء. أما عن التجهيزات التقنية الحديثة، فإن 29 إعدادية و21 ثانوية فقط تتوفر على قاعات للمعلوماتية.
ويرى الكاتب والإطار التربوي سيدي ولد سيدي أحمد أن البنية التحتية المدرسية «غير قادرة على إتاحة ولوج منتظم وشامل للأطفال في السن المحددة للتمدرس»، وذلك من واقع تقارير المفتشيات التربوية المقاطعية. ويَذكُر عدة أسباب لذلك العجز، منها: عدم ضبط الخريطة المدرسية، أي التوزيع العشوائي للمدارس لاعتبارات غير موضوعية، والعجز عن توفير إحصائيات دقيقة لمستويات الولوج ومعدلات التمدرس، إلى جانب فوضوية التقري وصعوبة ظروف الحياة في كثير من المناطق. ثم يشير ولد سيدي أحمد إلى تهالك العديد من المقار المدرسية القائمة، والتي أصبح بعضها يهدد سلامة التلاميذ، ليربط بين هذا العجز البنيوي وبين انخفاض النسبة الحقيقية للتمدرس.
إلا أن الخبير التربوي والمدير السابق للتعليم الأساسي محمدو ولد الصلاي يستغرب الضجة المثارة حول موضوع البنى التحتية المدرسية، ويرى أن «هناك دولا نجحت فيها مشاريع النهوض بالتعليم من خلال الاستثمار في المصادر البشرية فحسب، ومن دون تخصيص جزء من المشروع للبنية التحتية، بل هناك مَن يؤكد إمكانية الاكتفاء بالتدريس تحت الشجر.. بمعنى أن مجرد وجود الحجرات الدراسية بدون مدرسين مؤهلين ومحفزين، وبدون وجود وسائل تربوية مناسبة، وبدون آباء واعين لمسؤولياتهم تجاه الأبناء.. قد لا يكون أولوية ملحة».
الكتاب المدرسي
وإذا كان الكتاب المدرسي أولوية تربوية لا خلاف على أهميته، فهو أحد المشكلات المزمنة التي يعانيها النظام التعليمي الموريتاني، رغم الجهود المبذولة منذ سنين طويلة لتذليل هذه المشكلة، بما في ذلك إنشاء المعهد التربوي الوطني عام 1973 لكي يطلع بوضع مناهج ومقررات مدرسية موريتانية خالصة، بعد أن كان الاعتماد لسنوات على الكتاب المدرسي للدول المجاورة، على اعتبار أنها الأقرب إلى بيئة التلميذ الموريتاني، إذ تم تبني الكتاب المدرسي السنغالي في مادة اللغة الفرنسية والمواد المدرَّسة بها، والكتابين التونسي والمغربي في مادة اللغة العربية والمواد المدرَّسة بها. ثم أصدر المعهد في سنواته الأولى كتباً مدرسية كان لها دور كبير في بناء وعي الأجيال المتتالية من الموريتانيين في ذلك الوقت.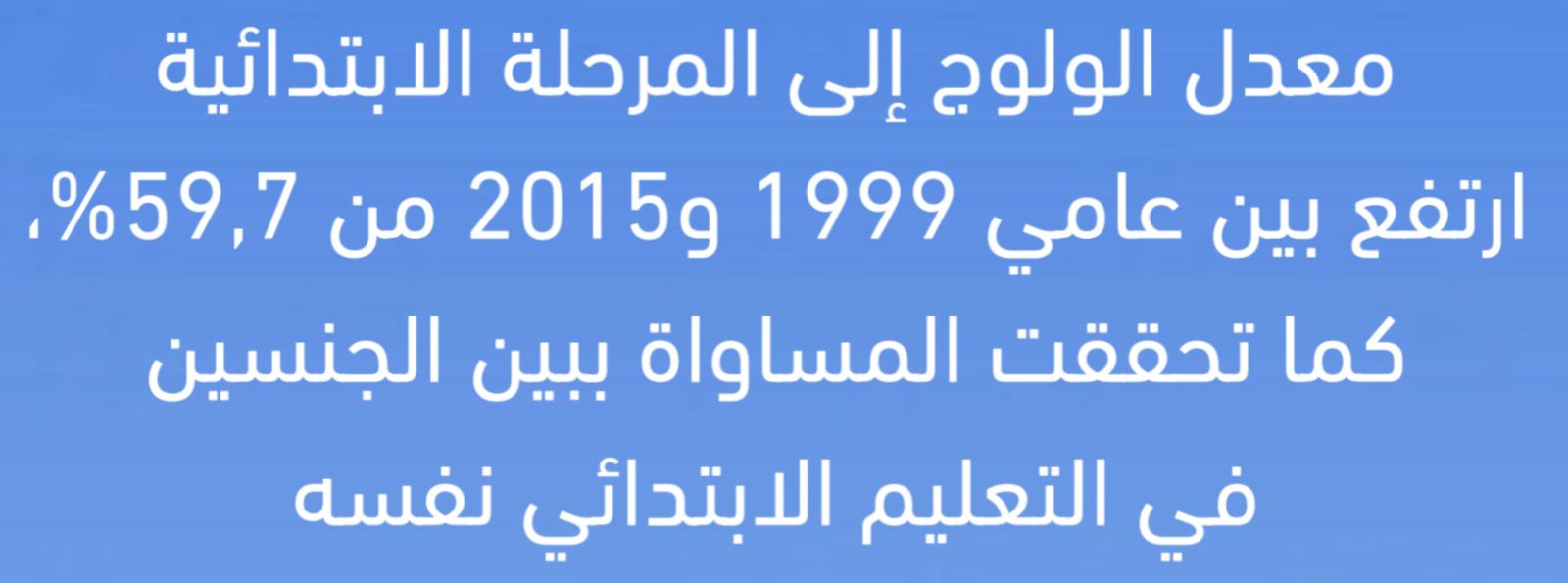
ويعتقد المختار ولد أوفى أن الكتاب المدرسي المستعار من دول الجوار قبل إنشاء المعهد التربوي الوطني «كان كتاباً جيداً، وكان يشد الطفل إليه وإلى محيطه، وقد تعلَّم من خلاله جيل كامل تعليماً جيداً». لكن الكتاب المدرسي الموريتاني عانى مشكلات جمة منذ التسعينيات، على رأسها، كما يقول ولد أوفى، «مشكلة المحتوى الذي لم يتكيف مع المتغيرات الجديدة، بل ظل محتوى جامداً»، كما عانى من مشكلة «شكله الإخراجي الذي ظل على حاله رغم أننا دخلنا عصر الرقمنة حيث تعوّد الأطفال على مواد بصرية مبهرة، وبالتالي لم يعد بالإمكان إقناعهم بالكتاب الجاف الذي ما عاد مستساغاً لذائقة جيل اليوم».
وإلى ذلك يعاني التلاميذ والمعلمون والأهالي من مشكلة النقص الحاد في الكتب المدرسية، وهو نقص يقدّره البنك الدولي بنحو 84 في المئة. بيد أن «هذه الكتب الناقصة كماً ونوعاً، لا يتم الالتزام باستخدامها داخل الصفوف الدراسية»، كما يشير إلى ذلك محمدو ولد بلال الخبير التربوي والرئيس السابق لمصلحة الامتحانات بوزارة التهذيب الوطني.
غياب المدرّس
ويواجه النظام التعليمي الموريتاني مشكلةً أخرى تتعلق بالمدرّس، العنصر الأهم في العملية التربوية. ووفقاً لإحصائيات وزارة التهذيب الوطني، فإن الوزارة تتوفر في عام 2018 على 19740 معلماً، أي بمتوسط معلم لكل 33.2 تلميذ. لكن الواقع أن معدل الكثافة في الفصول أعلى من هذا، إذ يوجد آلاف المعلمين الذين يعملون في وظائف غير تعليمية، كما يوجد «المعلمون الوهميون». لذلك يعتقد محمدو ولد بلال أن المشكلة لا تكمن فقط في نقص الكادر التربوي، وإنما أيضاً في «سوء استخدامه»، إذ بحسب المعلومات العامة -يقول ولد بلال- «توجد نسبة كبيرة من المعلمين والأساتذة تتقاضى رواتب وهي لا تعمل، وهذا مظهر من مظاهر الفساد الإداري الذي انتشر منذ تسعينيات القرن الماضي.. وقد شارك فيه أصحاب النفوذ بجميع أصنافهم».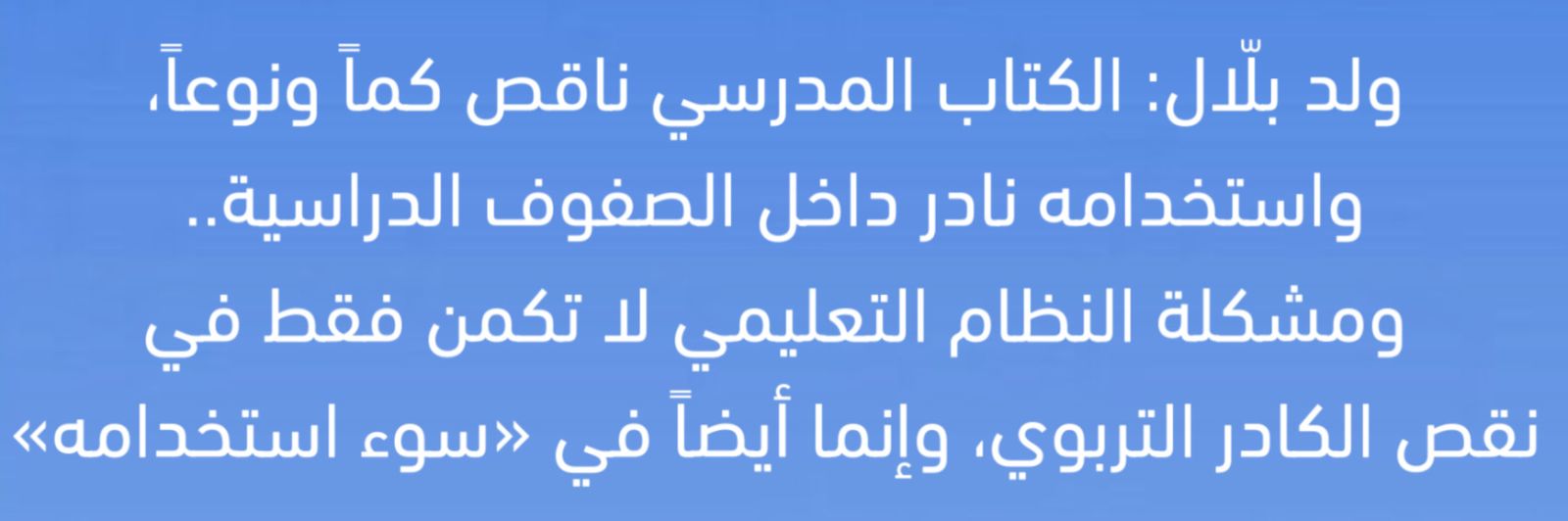
وقد ظل المعلمون الميدانيون، منذ بداية قيام النظام التعليمي العصري في البلاد، يقومون دائماً بتدريس جميع المواد لجميع الصفوف، لكن بداية من عقد التسعينيات أصبح بعضهم يضطر لتدريس أكثر من صف واحد في الوقت ذاته، وهو الإجراء المعروف باسم «دمج الفصول»، وقد تم تبنّيه في إطار سياسة تعليمية تركز اهتمامَها على الكم أكثر من الكيف.
إلا أن نقص الكفاءة المهنية لدى كثير من المدرسين يمثل مشكلةً أخرى للمنظومة التعليمية الموريتانية. لذلك يعتقد الدكتور محمد الأمين حمادي، وهو أستاذ جامعي عمل مستشاراً لدى عدة وزراء للتهذيب الوطني، أن معظم المدرسين لا يمتلكون الكفاءةَ المهنية اللازمة، وذلك لأنهم «لم يستفيدوا من التكوين الجيد، مع غياب شبه تام للتكوين المستمر». كما يقول إن 40% من معلمي المرحلة الابتدائية «لم يخضعوا لأي تكوين بيداغوجي أو تربوي». أما مستويات مدرِّسي المرحلتين الإعدادية والثانوية فهي منخفضة للغاية، إذ تشير اختبارات المستوى اللغوي التي خضعت لها عينة منهم إلى أن 14٪ منهم فقط يمتلكون المستوى المطلوب لتدريس اللغة العربية. أما في اللغة الفرنسية فلم تتجاوز نسبة الذين يمتلكون المستوى المطلوب 4%.
ثلاثة امتحانات كاشفة
ومع وجود مشكلات نقص البنى والتجهيزات المدرسية، واكتظاظ الفصول والافتقار إلى بعضها في كثير من المدارس، ونقص الكتاب المدرسي وانخفاض جودته، ونقص الكادر التعليمي وتدني مستواه.. جاءت التقييمات الموضوعية التي أجرتها مصالحُ إدارة التهذيب الوطني نفسُها، وكذلك نتائج الامتحانات الوطنية السنوية.. لكي تحذِّر كلُّها من تراجعٍ وتدهورٍ مستمرين للتعليم. فوفقاً لاختبارات أجرتها وزارة التهذيب الوطني لقياس مستوى استيعاب التلاميذ للمعارف والمهارات، اتضح أن نسبة نجاحهم في جميع المواد لم تكد تصل 35%، وفي الرياضيات على الخصوص لم تتجاوز 8.5%. كما دلت نتائج تلك التقييمات على تدني كبير لمستويات التلاميذ في اللغتين العربية والفرنسية، مما يفسر ضعفَ مستوياتهم في كل المواد.
أما الامتحانات الوطنية السنوية الثلاثة، وهي «مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية» (كونكور)، و«امتحان ختم الدروس الإعدادية» (بريفيه)، وامتحان الباكلوريا (شهادة الثانوية العامة).. فإنها تقدِّم الدليل على مستوى التلميذ الموريتاني وعلى نوعية أداء المنظومة التربوية الموريتانية نفسها. 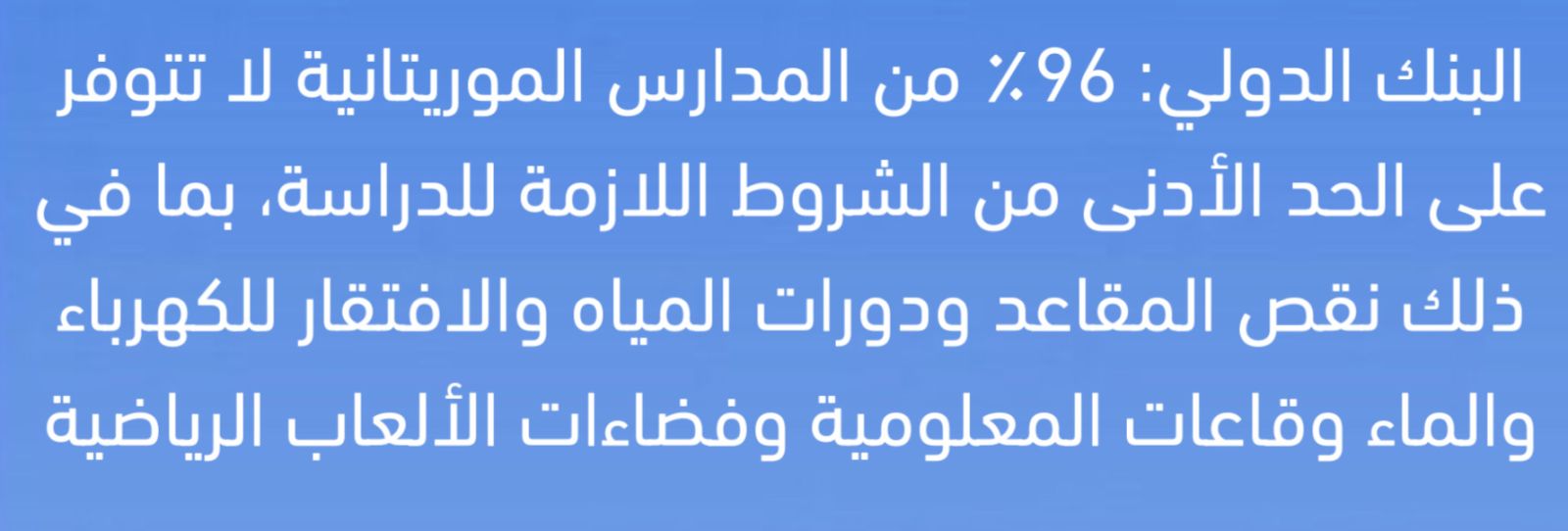
وقد مثّل امتحان مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية، عقبةً طالما حالت دون الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بالنسبة لكثير من التلاميذ الموريتانيين. وتشير نتائج هذه المسابقة خلال العام الدراسي الماضي 2020/2021 إلى وجود عدد كبير من التلاميذ الذين وجدوا أبواب العبور نحو المرحلة الإعدادية موصدةً أمامهم. فقد بلغت نسبة النجاح في المسابقة 53.83 في المئة، حيث استطاع 53303 تلميذاً التأهل لدخول السنة الأولى من الإعدادية من أصل 95264 شاركوا في المسابقة. لكن نسبة الناجحين تكون حوالي 50 في المئة فقط إذا ما احتسبنا العدد الكلي للمترشحين (أي بمن فيهم أولئك الذين ترشحوا ثم تغيبوا عن الامتحان). كما تقل نسبة الناجحين أكثر لو اعتمدنا المعيار الدولي متمثلا في حصول الطالب على نصف المجموع الكلي لنقاط الامتحان، بدلا من معيار 80/200 الذي اعتمدته الوزارة لرفع نسبة الناجحين. وخلاصة هذا أن نصف التلاميذ في الصف السادس ابتدائي تم إقصاؤهم بسبب تدني مستوياتهم الدراسية، وأن جزءاً كبيراً من الذين استطاعوا التجاوز إلى المرحلة الإعدادية هم في الواقع غير ناجحين، وبالتالي فهم مرشحون للرسوب أو التسرب خلال هذه المرحلة، أي من المرجح أن يفشلوا في الحصول على شهادة ختم الدروس الإعدادية «لبريفة».
وعلى النحو ذاته كانت أيضاً نتائج امتحانات شهادة «لبريفة» كاشفةً لمستوى أداء النظام التربوي ونوعية مخرجاته، فنسبة النجاح في امتحان هذه الشهادة للعام الدراسي 2021/2020 لم تتجاوز 19,8%، حيث بلغ عدد الناجحين 13329 تلميذاً من أصل 67396 شاركوا في الامتحان، بينما فشل في تجاوزه 51952 تلميذاً.
وفيما يخص امتحان الباكلوريا فقد كانت نتائجُه قاسيةً خلال العام الدراسي 2020/2021، حيث لم يتجاوز عدد الناجحين في الدورة الأولى منه 3742 من أصل 46587 مشاركاً، أي ما نسبته 8 في المئة، بينما تأهّل لخوض الدورة الثانية من الامتحان 3051 تلميذاً يمثلون نسبة 7 في المئة. وكانت نسبة النجاح في الباكلوريا للسنة الدراسية (2019/2020) قد بلغت 16٪، لكنها في السنوات التي سبقت ذلك ظلت تتراوح بين 12.8٪ (للعام الدراسي 2017/2018) كحد أقصى و7.26٪ (للعام الدراسي 2018/2019) كحد أدنى. وهي نتائج متدنية بالمقارنة مع نتائج امتحانات الباكلوريا في دول المنطقة، والتي سجلت خلال العام الماضي نفسه نسب نجاح خلال الدورة الأولى في كل من مالي (38.65 في المئة) والسنغال (44.65 في المئة) وتونس (45،57 في المئة) والجزائر (61.17 في المئة) والمغرب (68.43 في المئة). كما أنها متدنية حتى بالمقارنة مع نتائج الباكلوريا الموريتانية نفسها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث تراوحت نسبة النجاح فيها بين 58.25 في المئة عام 1974 و34.35 في المئة عام 1984.
أطفال خارج المدرسة
لقد شكَّلت نتائج الامتحانات الوطنية الثلاثة أعلاه خبراً سيئاً لعشرات الآلاف من الطلاب والأسر هذا العام، كما شكَّلته بالقدر ذاته تقريباً خلال الأعوام الماضية أيضاً. وبالدرجة نفسها فإن تلك الامتحانات كثيراً ما كوّنت عقبةً في المسار الدراسي للتلميذ الموريتاني وسبباً لانقطاعه عن المدرسة.
وقد ظل عدد التلاميذ الموريتانيين يزداد على مر السنين، بحكم انتشار التقري والتمدن وبمقتضى النمو الديموغرافي المرتفع نسبياً. وفي الفترة بين عامي 2010 و2018، أي خلال سبع سنوات فقط، ازداد عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية بـ102000 تلميذ، وعدد التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية بنحو 59000 تلميذ.. مما يعني أن النظام التربوي الموريتاني استطاع استقطاب واستيعاب معظم الأطفال ممن هم في السن القانونية للتمدرس.
ويعتقد ولد الصلاي أن معدلات الولوج إلى التعليم الأساسي «شهدت تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين، رغم وجود جيوب ما زالت تعاني من نقص خدمة التعليم، بل وغيابها أحياناً، وذلك لأسباب سوسيو ثقافية واقتصادية». أما المرحلة الثانوية فيرى أنها «ما زالت تعاني من تدني نسبة الالتحاق بسبب ضعف المستويات من جهة، ومحدودية القدرة الاستيعابية للتعليم الثانوي نفسه من جهة أخري». 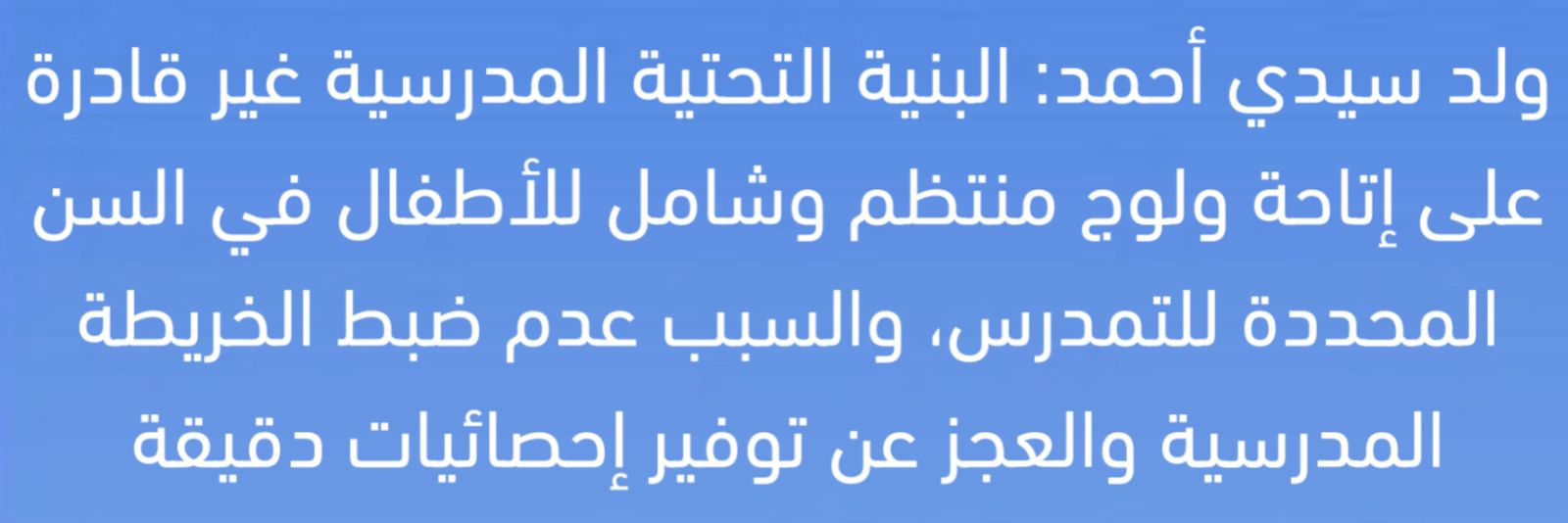
وقد رفعت الحكومة الموريتانية في تسعينيات القرن الماضي شعارَ «التعليم للجميع في عام 2000»، ووعدت بإتمام التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، وبتحسين الملاءمة والجودة في مستويات ما بعد المرحلة الابتدائية. وفي الفترة بين عامي 2000 و2013 ارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالية بالتعليم من 88٪ إلى 97٪، كما زادت معدلات إتمام المرحلة الابتدائية من 53٪ عام 2002 إلى 71٪ عام 2013، وذلك وفقاً لمعطيات المكتب الموريتاني للإحصاء.
وقد لاحظ البنك الدولي في تقريره لعام 2020 حول موريتانيا تقدماً في الولوج إلى التعليم فيها، خصوصاً بالنسبة للمرحلة الابتدائية حيث ارتفع معدل الولوج من 59,7% إلى 79,2% ما بين سنتي 1999 و2015، كما تحققت المساواة ببين الجنسين في التعليم الابتدائي نفسه. أما معدل التمدرس الخام فانتقل من 99,68% عام 2010 إلى 99,89% عام 2018، بينما وصل معدل التمدرس الصافي في عام 2018 إلى حوالي 79,6%.
لكن محمدو ولد بلال يشير إلى أن نسبة التمدرس المعلنة في أكثر الأحيان ليست نسبة التمدرس الصافي وإنما نسبة التمدرس الخام، والتي قد تزيد على 100٪ أحياناً، وذلك لأنها لا تراعي أعمار التلاميذ في المرحلة الابتدائية (6-12).
ويشرح المختار ولد أوفى مفهوم «التمدرس الخام»، قائلا إنه مؤشر فني اعتمده البنك الدولي لتقييم البرامج التعليمية في الدول النامية، وأنهم لاستخراج هذه النسبة يضربون في 100 عددَ مجموع الأطفال المسجلين (بغض النظر عن أعمارهم)، ثم يقسمون الرقم على عدد أطفال الفئة العمرية المسجلة في مرحلتها الدراسية الحقيقية. وبما أن بعض الأسر تدخِل أطفالَها المدرسةَ قبل سن السادسة أحياناً وبعدها أحياناً أخرى، فإن البسط في ذلك الكسر الحسابي قد يكون قريباً من المقام أو حتى أكبر منه، ومن ثم تأتي نسبة التمدرس الخام مرتفعةً وقد تصل 100٪ أو أكثر منها. ويضيف ولد أوفى أن هذه الطريقة في احتساب التمدرس «اقترحها البنك الدولي وقبلت الدول النامية العملَ بها كي تغطي النقص في التمدرس وتداري عجز النظام التربوي، ولتحسّن بها مؤشرات التنمية الاجتماعية». أما الطريقة الحقيقية لحساب معدل التمدرس الصافي فهي خارِجُ قسمة عدد الأطفال المسجلين من الفئة العمرية (6-12) على مجموع الأطفال من الفئة العمرية ذاتها مضروباً في 100». وفي هذه الحالة فقط، يقول ولد أوفى، يمكن أن نقول إن نسبة التمدرس مطابقة للواقع.
وربما تكون قريبةً من الواقع معطياتُ المكتب الوطني للإحصاء، لعام 2015، والتي تشير إلى أن 25٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات، و11٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقاً.
وكذلك الدراسة التي أجرتها اليونسيف حول الأطفال غير المتمدرسين والأطفال المنقطعين عن المدرسة في ولايتي غديماغا ونواكشوط الجنوبية، وقد جاء فيها أن الأطفال المنقطعين عن المدرسة من الفئة العمرية (6-8 سنوات) يمثلون 21٪ من إجمالي أطفال هذه الفئة العمرية. وترتفع هذه النسبة لتصل 56٪ بين أبناء الفئة العمرية (12-14). وقد أبرزت الدراسة نفسها أن 25٪ من الأطفال ممن هم في سن الدراسة في عام 2016 لم يلتحقوا أبداً بالمدرسة الابتدائية، وأن هذه النسبة بلغت 27٪ في نواكشوط عامةً (بولاياته الثلاث)، و32٪ في ولاية نواكشوط الجنوبية، و26٪ في ولاية كيديماغا. أما على المستوى الوطني فبينت الدراسة أن نسبة التمدرس الصافي في المرحلة الابتدائية لا تتجاوز 75٪.
وقد لاحظت اليونسيف أن نسبة الاطفال غير الملتحقين بالمدرسة في عام 2015 كانت 19٪ على الصعيد الوطني، لكنها ارتفعت في العام التالي لتصل 25 في المئة. كما لاحظت أن ثلث الأطفال الذين يدخلون السنة الأولى من المرحلة الابتدائية ينقطعون عنها قبل أن يكملوا هذه المرحلة.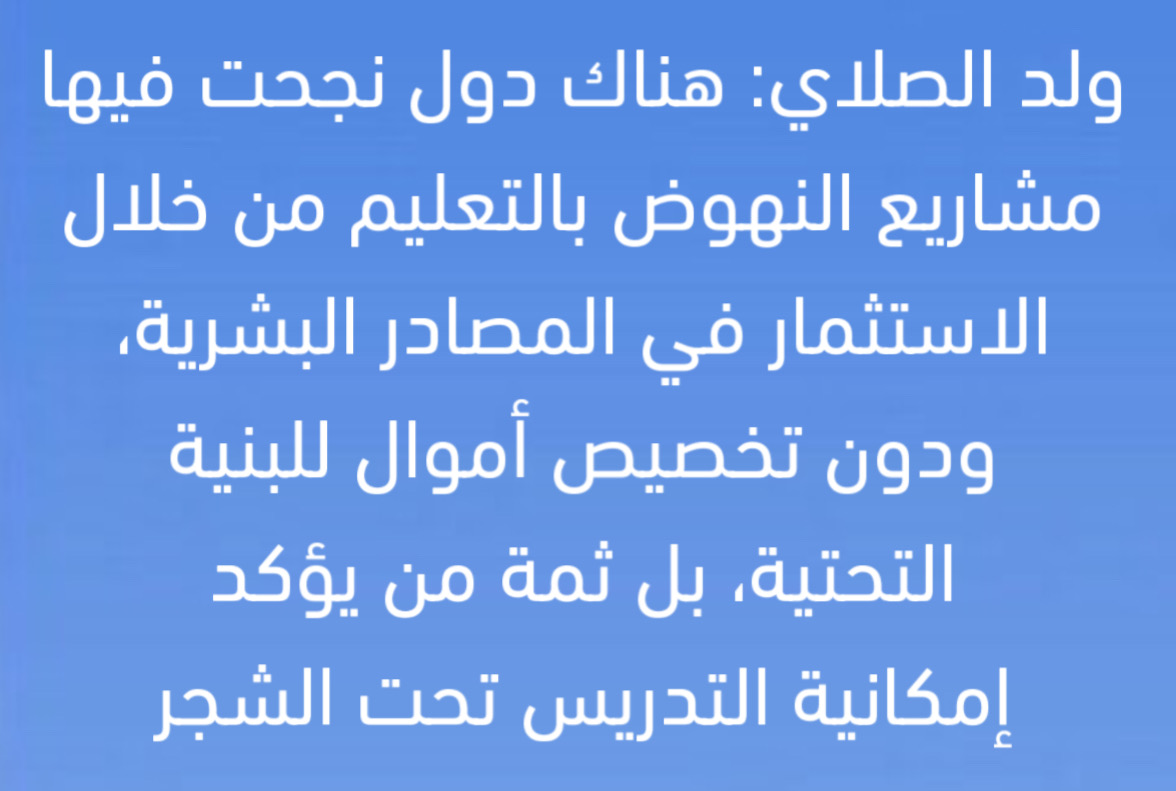
ويتضح من تقديرات اليونسيف آنفة الذكر، ومعطيات المكتب الوطني للإحصاء الذي قدّر عدد الأطفال الموجودين خارج النظام التعليمي في عام 2015 بنحو 230.000 طفلاً، منهم 109.000 لم يلتحقوا بالمدرسة أصلا.. يتضح من ذلك أنه ما يزال هناك عدد كبير من الأطفال الموريتانيين (ممن هم في سن التمدرس) خارج النظام التعليمي. ولهذا السبب أطلقت السلطات الموريتانية في عام 2015، والذي أعلنته «سنةً للتعليم»، خطةً لمحاربة التسرب المدرسي. كما كشف وزير التهذيب الوطني في حينه «آب عصمان»، أرقاماً أخرى حول تعداد الأطفال الذين يوجدون خارج الفصول الدراسية، وقال إن نحو 182 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً يوجدون خارج الصفوف المدرسية، وهو ما يمثل 27% من الفئة العمرية المستهدفة بالتعليم في البلاد.
حواجز ومنفرات
وفيما يخص الأسباب التي تحول دون ولوج المدرسة أو تدفع للتسرب منها، فهي كثيرة كما يقول محمدو ولد بلال، والذي يذكر منها: التقري العشوائي، نقص المعلمين، اكتظاظ الفصول، الظروف المعيشية الصعبة، بعد المدرسة من منزل الأسرة، وحاجة الأسر إلى عمل الأبناء سواء في الأرياف أم المدن.
أما المختار ولد أوفى فيذكر إلى جانب تلك الحواجز منفِّرات في مقدمتها «نوعية المقاربات التربوية، إذ هي في أغلبها مقاربات غير جاذبة، بل منفِّرة وطاردة في كثير من الأحيان». ويضيف إليها سبباً آخر هو «فشل النظام التعليمي في تغيير وتحسين واقع مَن أكملوا مراحله، سواء بسبب نوعية التعليم نفسه وكونه غير متوائم مع معطيات المجتمع واحتياجات سوق العمل، أم بسبب الضعف الاقتصادي والتأخر التنموي اللذين يحولان دون استيعاب أصحاب المؤهلات التعليمية في الدورة الاقتصادية». كما يذكر سبباً آخر لا يقل أهمية ألا وهو الفقر؛ ذلك أن «كثير اً من الأسر في الطبقات الفقيرة والهشة تعجز عن توفير المال اللازم لتأمين الأدوات والكتب المدرسية علاوة على الملابس والطعام.. لصالح أطفالها. لذا فهي تزهد في إرسالهم إلى المدرسة، وبدلا من ذلك تعتمد عليهم في الريف في أعمال الرعي والفلاحة والأنشطة المنزلية، وفي المدينة تتركهم يتسكعون في الشوارع حيث يعودون أحياناً ببعض النقود أو الطعام مقابل عمل يدوي أدَّوه لآخرين».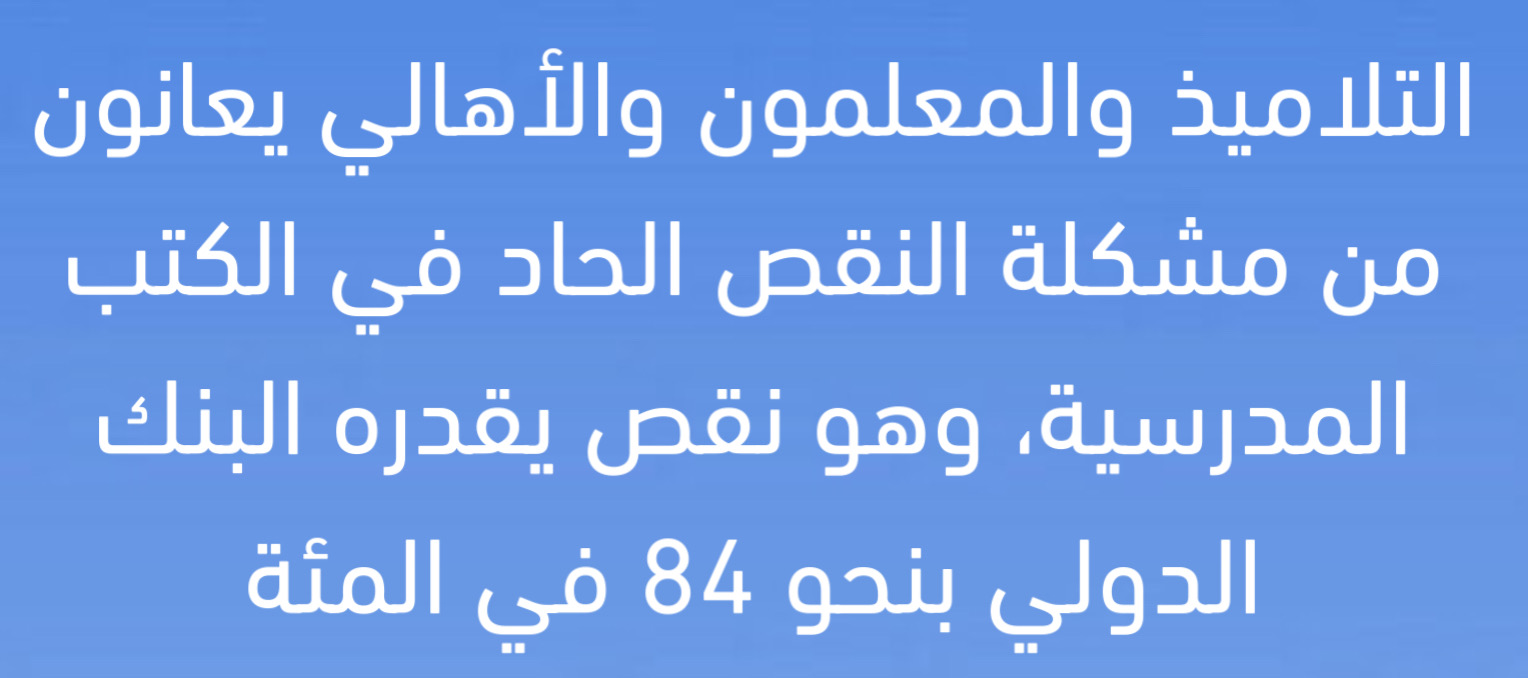
من المدرسة.. إلى أين؟
وتكاد تتفق تقديرات اليونسيف والبنك الدولي والمكتب الوطني للإحصاء على أن حوالي ثلث الأطفال الموريتانيين الملتحقين بالتعليم الأساسي يغادرون المدرسة قبل إنهاء المرحلة الابتدائية.. ليبرز السؤال الأهم: إلى أين يذهب هؤلاء بعد أن عجزت المدرسة عن الاحتفاظ بهم؟
يتحول تسرب التلاميذ من المدارس إلى مشكلة اجتماعية وأمنية حين لا يجد هؤلاء التلاميذ الذين فشلوا في إكمال المرحلة الابتدائية أو الإعدادية مساراً تكوينياً بديلا يسمح لهم باكتساب مهارات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل. وتتضح خطورة هذه الوضعية من نتائج الدراسة التي أجرتها اليونسيف عام 2018 حول ظاهرة التسرب المدرسي في موريتانيا من خلال ولايتي كيديماغا ونواكشوط الشمالية، والتي أوضحت أن 11،5 في المئة من المتسربين مدرسياً يلتحقون بعمل يدوي، لكن 65 في المئة منهم لا يجدون أمامهم غير الفراغ. ومن اللافت للانتباه أن هذه النسبة الأخيرة هي نفسها نسبة المتسربين من المدرسة بين نزلاء «مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون»، بناءً على الجرد الذي أجريناه حول مستوياتهم الدراسية، بينما لم تلتحق البقية بالمدرسة أصلا.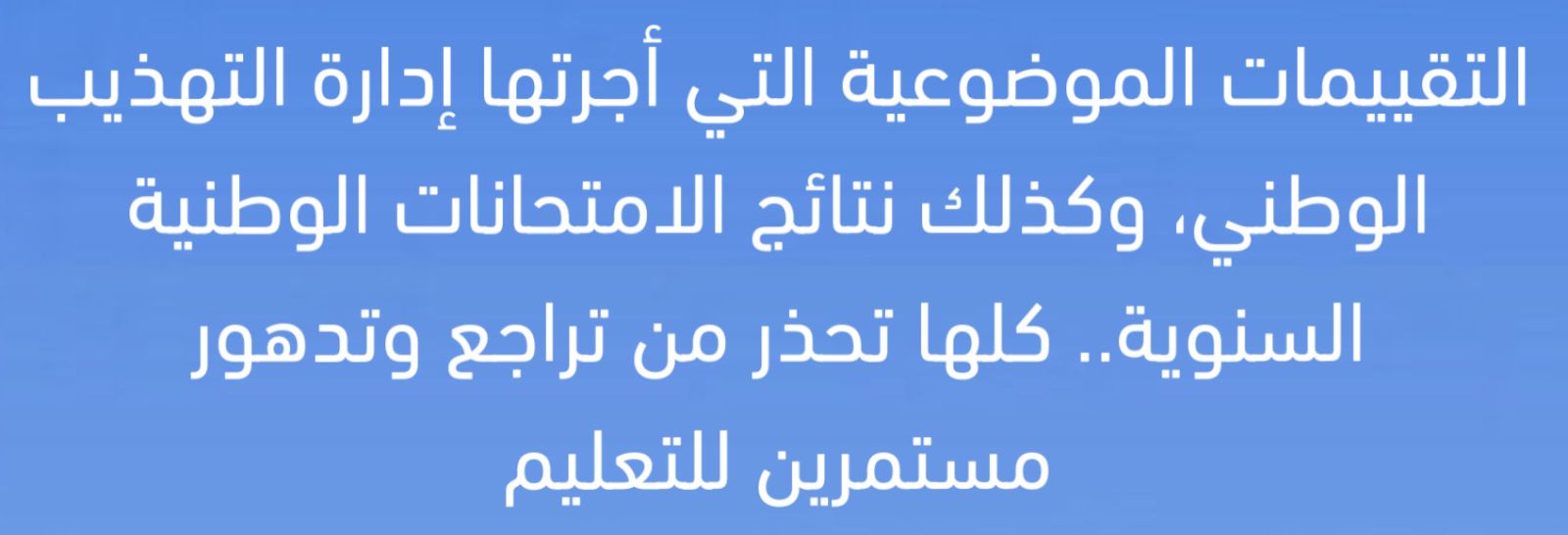
وربما لذلك السبب يعتقد الدكتور سيدي محمد ولد الجيد أن النظام التربوي الموريتاني يعاني من هشاشة ترتبت عليها «آثار موجعة تجسدت من بين أمور أخرى في ارتفاع صاروخي لمعدلات التسرب المدرسي، ناهيك عن العزوف عن التمدرس أصلا لأسباب ثقافية واقتصادية واجتماعية». وهو يرى أن هذه الوضعية أدت إلى «وجود جحافل من الشباب غير المتعلمين وقليلي التكوين والتأهيل، والمنهكين بهول الخصاص وضيق ذات اليد، والمفتونين ببهارج العولمة.. وهو ما جرَّ ويجر الكثير منهم إلى وحل الانحراف والتردي في براثن الجريمة والتطرف وتعاطي المخدرات».
كما يتحدث المحامي والوزير السابق حيمودة ولد رمظان عن الأسباب المؤدية إلى تزايد انحراف الطفولة، في ظل انتشار الفقر وتراجع أداء النظام التعليمي، محذِّراً من «عدم وجود برامج تأهيل وإعادة إدماج واضحة تمكّن الأجهزة المختصة من القيام بالدور المطلوب»، وداعياً إلى «الإشراك الفعال لجمعيات المجتمع المدني في نشر التوعية حول أخطار الانحراف والعواقب المترتبة عليه».
وحول هذه العواقب، يلفت ولد أوفى إلى الفاقد الاقتصادي والمجتمعي المترتب على ظاهرة التسرب المدرسي، والتي تضع آلاف المراهقين والشباب سنوياً خارج الدورة الاقتصادية للمجتمع، بل على هامش الحياة وفي مواجهتها أحياناً. لكنه يتحدث كذلك عن العواقب الأمنية لهذه الظاهرة، قائلا: «في البلدان الهشة التي عرفت قلاقل منذ بعض الوقت، مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو، وهي بلدان تقع في منطقة الساحل والصحراء التي تضم موريتانيا أيضاً، بدأت الجماعات المسلحة هناك تكتتب الأطفال المحرومين من التعليم والمتسربين منه». وانطلاقاً من خبرته في العمل لعدة سنوات كخبير إقليمي لدى منظمات دولية في المنطقة، يقول ولد أوفى: «إن الطفل حين يبلغ سن السادسة عشر يصبح بإمكانه حمل بندقية الكلاشنكوف، وهذه لا يستغرق التدريب على استخدامها أكثر من أربعة أيام. وكذلك يمكنه التدرب على قيادة الدراجات النارية التي يستخدمها المسلحون في عملياتهم هناك. وبهذا يصبح الطفل مقاتلا». ويوضح ولد أوفى أن العمل كـ«مقاتل» أصبح مهنةً من المهن في بلدان الساحل والصحراء، و«حين يقال (فلان مقاتل)، فمعنى ذلك أنه عنصر مكتتب في إحدى المليشيات المحلية أو الجماعات المسلحة المتطرفة، وهي تدفع له شهرياً بين 60 و70 دولاراً». كما يمكن لـ«المقاتل» أن يؤدي عملا آخر، وهو أن «يوفر المرافقةَ والحمايةَ لجماعات التهريب، ومنها الجماعات التي تهرّب المخدرات، إذ يكتتبونه لمدة أيام كي يؤمّن لهم طريق الوصول إلى حدود ليبيا والتشاد، حيث يقوموا هناك بفرز وتقسيم بضاعتهم؛ فالأقراص منها تذهب إلى منطقة المشرق العربي، بينما يذهب الحشيش إلى التشاد ونيجيريا، أما الكوكايين القادم من كولومبيا فيأخذ طريقه إلى أوروبا».
وأثناء إعدادنا هذا الملف واللقاءات التي أجريناها بعدة مسؤولين أمنيين وقضائيين حول جرائم القصّر، ومن خلال اطلاعنا على ملفات بعضهم والظروف التي ارتكبوا فيها جرائمهم، اتضح أنهم جميعاً كانوا يتعاطون المخدرات، وكانوا واقعين تحت تأثيرها لحظةَ اقترافهم الجرائمَ المنسوبةَ إليهم. وحول هذه الجزئية يقول الكاتب والناشط الثقافي والجمعوي محمد الأمين ولد الفاظل إن جميع الأطفال مرتكبي الجرائم يشتركون في استخدامهم أسلحة بيضاء، وفي كونهم أصحاب سوابق إجرامية، علاوةً عل تعاطيهم المخدرات. لكن من أين تأتي المخدرات إلى البلاد؟ وكيف يحصل عليها أطفال عائلات فقيرة في الغالب؟ يجيب ولد الفاظل: «بلادنا تشكل نقطة عبور للمخدرات، وربما يتم استبقاء بعض تلك المخدرات وبيعها داخل البلاد.. ثم إن الشاحنات التي تأتي من بعض الدول الشقيقة محملةً بالخضروات والفواكه، تأتي معها بمواد أخرى قد تستخدم لصنع المخدرات. لكن المشكلة لدينا ليست في إدخال المخدرات، فالكثير من الشباب الذي يتعاطاها يقوم بصناعتها محلياً، أو يأخذها من مصنِّعيها المحليين، وهم يستخدمون لذلك بعض الأقراص الطبية والغراء والعطور.. إلخ». 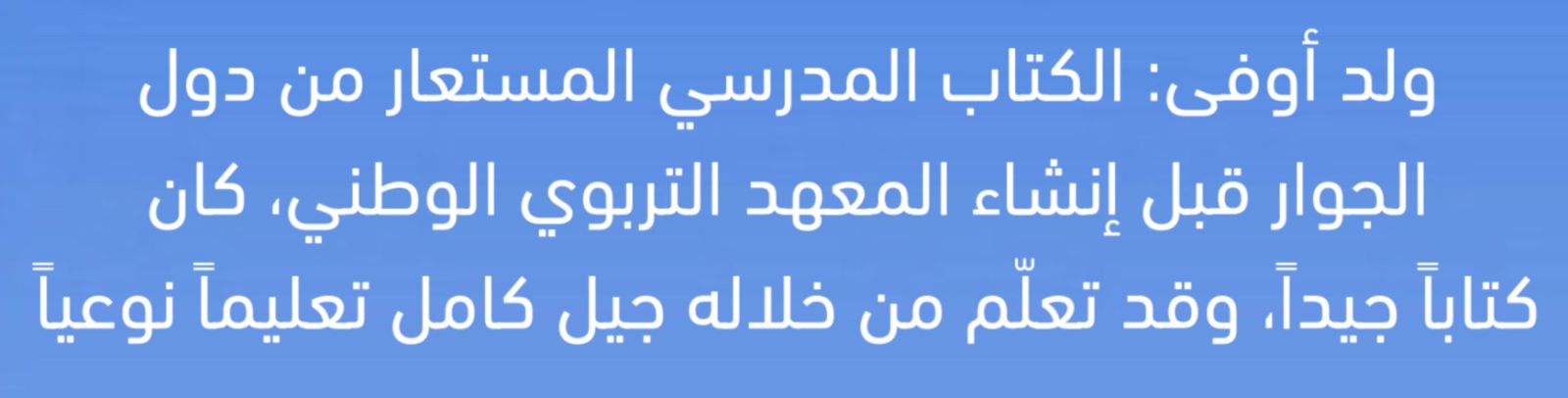
ويتقاطع هذا الرأي مع تصريح غير رسمي أدلى به أمامنا، خلال إعداد هذا الملف، أحد ضباط شرطة الأحداث الجانحين في نواكشوط، حين أوضح أن تعاطي المخدرات موجود في كل الحالات التي وصلت مركزَه، وكذلك الفشل الدراسي أيضاً. ثم أضاف أن الصغار يبدؤون بارتكاب السرقة غير الموصوفة (الاستيلاء على الأشياء البسيطة غير المحصّنة)، ثم ينتقلون إلى السرقة الموصوفة باستخدام الكسر والاقتحام، ثم استعمال المخدرات، ثم الاعتداء باستعمال السلاح الأبيض.. إنْ كعناصر منفردة وإنْ من خلال عصابة إجرامية منظمة. كما شدد على أن كل ذلك يحدث في غياب تام لأي دور إيجابي من جانب الأسرة والمدرسة معاً.
افتح مدرسةً تغلق سجناً
يجمع الخبراء الذين حاورناهم في هذا الملف على التوصية بمجموعة من الإجراءات والتدابير والسياسات والمقاربات الضرورية للحد من جرائم صغار السن، بما في ذلك تعزيز المنظومة التشريعية، ودعم الوسائل المادية والبشرية لشرطة القُصَّر، وتشديد الرقابة على المخدرات، ونشر الوعي الأسري، وتقوية العلاقة بين الأسرة والمدرسة.. كما يؤكدون كلُّهم على ضرورة الدور الذي ينبغي للمنظومة التعليمية أن تطلع به من أجل إيجاد بيئة تربوية تحبب المدرسةَ إلى الأطفال وتساعد على جذبهم للاندماج والاستمرار فيها ومنعهم من الانقطاع عنها. 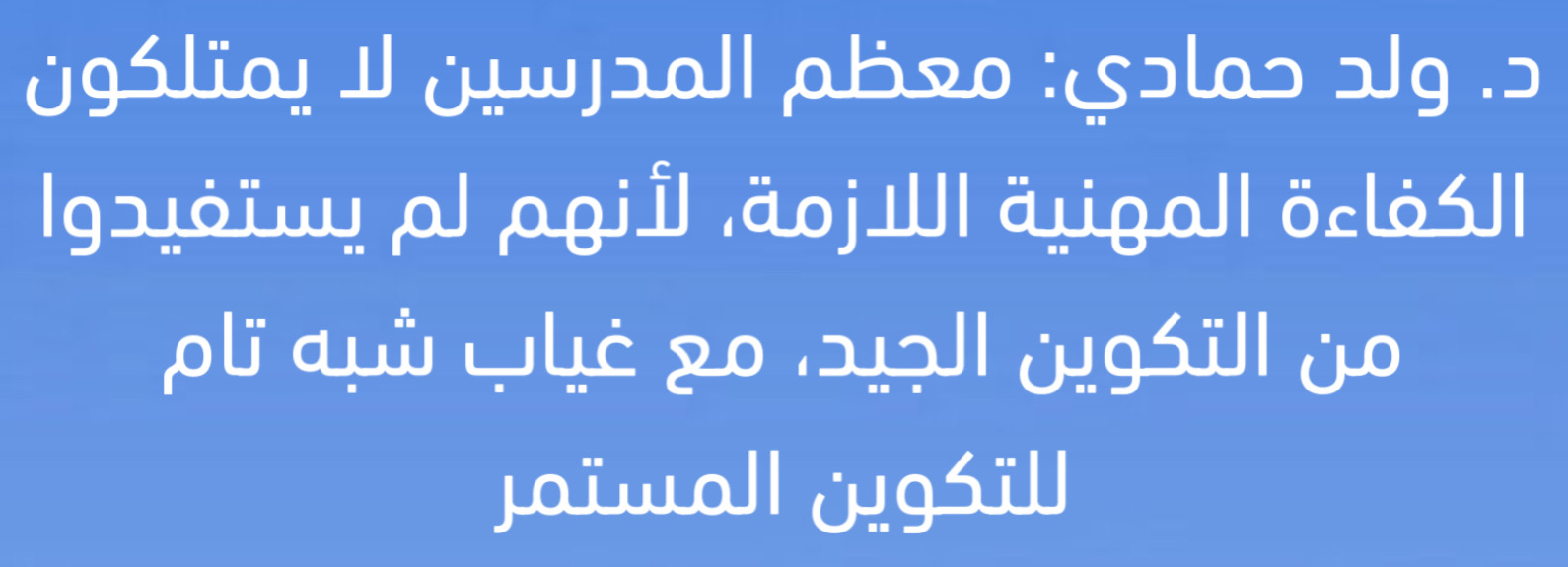
يقول أديب التنوير الفرنسي فيكتور هيجو: «مَن يفتح بابَ مدرسة يغلق بابَ سجن»، في دلالة دقيقة على دور التعليم في تهذيب النشء وتزكيته وتحصينه ضد الانحراف والعنف وباقي الرذائل السلوكية الأخرى. والمدرسة التي نقصدها هنا إنما هي المدرسة العمومية (الحكومية)، كونها المؤسسة التي ظلت حاضناً تعليمياً لأطفال أسر الطبقات الفقيرة، والذين تأتي من صفوفهم الآن غالبية الجانحين ومرتكبي الجرائم من صغار السن.
وفي الوقت الذي كان فيه المجتمع الموريتاني يمر بمرحلة انتقالية جراء تحوله من البوادي والأرياف إلى سُكنى العاصمة، وما يصحب مثل هذا النزوح -المألوف جداً في بلدان العالم النامي- من تبدلات قيمية واضطرابات سلوكية، وكان على التعليم الاطلاع بالعبء الأكبر في حماية المجتمع وتقوية مناعته إزاء الآثار السلبية لهذا الانتقال وتداعياته.. كان التعليمُ نفسُه ضحيةً لسياسات تراوحت بين الإهمال شبه التام، والتخطيط العشوائي غير المنضبط بأي أهداف أو معايير موضوعية، والدعاية السياسية الديماغوجية ذات الشعارات البراقة.. وليس انتهاء باستغلال التعليم ذاتِه لجلب التمويلات والمعونات الأجنبية. وفي مناخ السياسات التعليمية القائمة، لم يستطع المدرّس أن يحظى بالمركز المعنوي والمادي الذي يجعله قدوةً أو مثالا مؤثراً في مجتمع غزته فجأة ثقافةُ العولمة وقيمُ أنماطها المادية الاستهلاكية المفرطة. كما لم تستطع المدرسةُ، بوسائلها المادية والبنيوية المتواضعة وكوادرها البشرية المهمَلة ومحدودة التكوين ومناهجها العتيقة الجافة.. أن تصبح بيئةً حاضنةً وجاذبةً للتلميذ، ولا حتى قادرةً على موازنة ما يتعرض له خارجها من مؤثرات سلبية. وإلى ذلك فقد وضع النظام التعليمي عراقيلَ وعوائق في طريق التلميذ الموريتاني تجسدت في الامتحانات الوطنية السنوية الثلاثة التي كثيراً ما وُصفت نتائجها كل عام بـ«الكارثية». ورغم أن القلة القليلة فقط هم مَن يتجاوزون هذه الامتحانات، فإن الأغلبية من هذه القلة القليلة لا يَظهر في حياتهم أي أثر إيجابي للتعليم من شأنه إقناع التلاميذ الآخرين بالاستمرار في مسارهم الدراسي.
وفي غياب الخيارات المهنية التكوينية العملية البديلة، يذهب كثير من الأطفال المتسرّبون من المدرسة إلى الشارع، فيمارس بعضهم أعمالا يدويةً غير مصنفة، وقد يلتحق بعضهم بعالم الجريمة، وربما يصبح البعض من هؤلاء مهيؤون لولوج عالم الإرهاب ضد مجتمع لم يُتح لهم الأسباب الكافية للتنشئة الصحيحة ولا الشروط الموضوعية للاندماج الإيجابي ولبناء مستقبل يعيشون فيه حياةً كريمةً.
وعلى تلك الخلفية، وبصفة خاصة تحت تأثير الصدمات الدراسية لعام 2021 والفزع الذي أثارته جرائمُ الأحداث خلال هذا العام، يتساءل كثير من الموريتانيين: إلى أين نتجه في ظل النظام التعليمي بأوضاعه الحالية؟ وما العمل في مواجهة صغار فشلوا دراسياً فأصبحوا مصدر ترويع لمجتمع عاصمة بلدهم؟


























